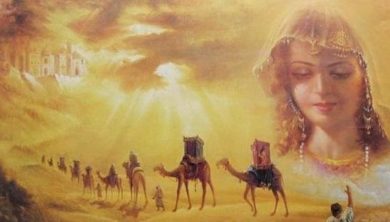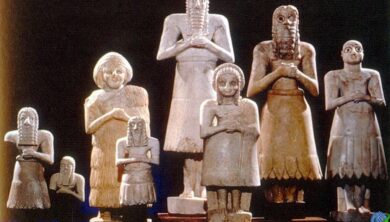“بلا حشومة، الجنسانية النسائية في المغرب” لسمية نعمان جسوس… أعطاب قديمة تتجدد
الأعطاب التي سلطت عليها الكاتبة الضوء، قبل 38 سنة من صدور الطبعة الأولى لـ “بلا حشومة، الجنسانية النسائية في المغرب”، لا زالت قائمة، وبأشكال متعددة.
وكأن من حق المجتمع أن يمارس الوصاية على أجساد النساء، فلا زال الزواج يعد “جنة الخلاص” من الأسر المتسلطة، ولا زال يُنظر للمرأة كأداة لتلبية الرغبة الجنسية للرجل، ولا حق لها في الاعتراض، ولا زالت الكثير من النساء يتحملن العنف الجنسي ويرفضن الحديث عن ذلك، بغاية الحفاظ على “الأسرة”، وتحت ذريعة “حشومة”، هذه العبارة التي جعلت الحديث عن “الجنسانية النسائية” يكون همسا، بدل أن يكون بصوت مرفوع.
قد يتبادر إلى ذهن القارئ أن الكتاب موضوع القراءة، حديث الإصدار، لكن الأمر يتعلق بكتاب لعالمة الاجتماع سمية نعمان جسوس، تحت عنوان: “بلا حشومة: الجنسانية النسائية في المغرب”، إذ لقي اهتماما خاصا من قبل الإعلاميين والمتخصصين في أول طبعة له سنة 1987، ليتم إعادة طبعه 14 طبعة، نظرا لكثافة الإقبال عليه، ولأهمية القضايا المطروحة فيه، ولا زال يعتبر مرجعا أساسيا فيما يتعلق بالجنسانية النسائية.
ساهم استناد سمية نعمان جسوس للمنهج العلمي في توسيع شبكة القراء، عن طريق الاستعانة بالجانب الميداني، إذ أجريت الدراسة في الفترة الممتدة من 12 أكتوبر 1981 إلى 28 غشت 1984، باختيار عينة مكونة من 200 امرأة بمدينة الدار البيضاء، من مختلف الاعمار والأوضاع الاجتماعية (عازبات، أرامل، مطلقات، متزوجات)، وباختلاف المستويات التعليمية.
بأسلوبها الجريء وتسميتها للأشياء بمسمياتها دون حضور مفهوم “الحشومة”، تخوض الكاتبة في قضايا الجنسانية بشكل معمق، فالكاتبة كانت جد صريحة حين اختارت أن تكون أول كلمة من عنوان هي”بلا حشومة”، كإشارة مسبقة أن الكتاب سيخوض في طابوهات وقضايا نسائية متعلقة بالجنسانية، وغالبا لا تكون مقبولة لدى المجتمع، وهذا ما يميز أبحاث سمية نعمان جسوس بجرأتها فيما يتصل بقضايا المرأة المغربية، فقد سبق لها أن تناولت مواضيع جد حساسة كـ”المساواة في الإرث” و”الاغتصاب الزوجي”، في الوقت الذي كان من العار الحديث عنها.
عمدت الكاتبة في بداية الدراسة إلى بيان مدلول كلمة “حشومة”، وبأنها تستعمل في غير سياقها، نظرا لخضوع المجتمع لثقافة “الحشومة”. المقصود بهذه العبارة، حسب الباحثة، ليس “الحرام” أو “الخجل”، لأن الحرام محدد في القرآن والسنة، وأن مفهوم “حشومة” ما هو إلا انعكاس للتشبث بالتقاليد التي أدت إلى انحراف الممارسات الاجتماعية والاتجاه بها نحو مقاصد أخرى لحماية المصالح الخاصة فقط، وبينت الباحثة مدلول كلمة حشومة قبل الخوض في الفصول الأساسية للكتاب، بغرض تجنب التباس هذا المفهوم مع مفاهيم أخرى مشابهة.
تضمن الكتاب 3 فصول، قاربت من خلالها إشكالات واقعية لا زالت تخل بتوازن المرأة داخل المجتمع، وجاء الفصل الأول المعنون بـ “قبل الزواج، فضاء البيت المغلق”، إذ تطرقت للتمييز على أساس الجنس داخل البيت، وبداية نشوء الصراع بين الجنسين، إلى جانب تأثير الانغلاق والسيطرة الأسرية على الفتاة، وكلها مظاهر سلبية تنعكس على تفاعلها داخل المجتمع، وتولد لديها الرغبة في التمرد، ليكون المنفذ الأول أمامها هو: “العالم الافتراضي” الذي تعبُر من خلاله الفتاة، بغاية خلق علاقات جديدة، واكتشاف الجنس الآخر.
أما عن رؤية الفتيات للعلاقات مع الرجال، فلا زال يتحكم فيهن هاجس الزواج والحصول على الملذات المادية، دون وجود نظرة واضحة للغاية من الزواج أساسا، ويكون الزواج وسيلة للهروب من الآثار السلبية للانغلاق الأسري الذي عاشته في الطفولة.
أما عن التربية الجنسية، فأشارت الكاتبة للمخلفات النفسية لـ”الحيض الأول”، إذ يمتزج لديهن الحيض المفاجئ بالخوف والخجل، دون وجود توضيحات مسبقة من قبل أمهاتهن اللواتي يمعنّ في التكتم، وتكون معلومات الفتيات في هذه المرحلة، إما خلسة في التجمعات النسائية أو عن طريق العمة أو الأخت الكبرى، ونبهت الكاتبة لبعض الطقوس التي تصاحب الفتاة في أول “حيض” لها كتزيينها، ووضع الحناء…متأسفة على انحسارها، بالإضافة للتنبيهات المتلاحقة للفتاة بمجرد أن “تبلغ”، لكون جسدها مكتملا ومهيأً للممارسة الجنسية، مما يستدعي منها أخذ الحذر لتجنب الأطماع الجنسية للرجال.
تناولت الكاتبة، كذلك، مسألة التجربة الجنسية الأولى قبل الزواج، حيث يكون الشعور الطاغي آنذاك هو الندم، الإثم والعار، ما تخلفه من مخاوف لدى المرأة كصعوبة التحكم في الحمل، والاجهاض.
أما الفصل الثاني من الدراسة، والمعنون بــ”الزواج، فعل اجتماعي وحياة يومية”، فقد تناولت فيها الباحثة، في مستهل الدراسة، الارتباط الحر الذي وصفته بأنه “لم يكن أبدا تجليا للاستقلالية النسائية”، والرفض المجتمعي لهذا النوع من العلاقات. أما عن مؤسسة الزواج، فقد أصبحت تجسد أدورا أخرى كـ”أداة لتحقيق الأمان” أو الترقي الاجتماعي، ووسيلة للانعتاق من القيود الأسرية، مما يبين انحراف “العلاقة الزوجية” عن مقاصدها واعتبارها مجرد طريق لتحقيق الامن المادي.
تؤدي كل هذه التداخلات منها ما هو أسري، مجتمعي، ونفسي، لتكرار نفس الحياة التي كانت ترجو المرأة الهروب منها، وتندثر معها باقي حقوقها، خصوصا عند الاصطدام مع أم الزوج (الحماة). هذه الأخيرة تلعب دورا كبيرا في اخضاع “زوجة الابن” لسلطة خانقة.
وصفت سمية نعمان جسوس الاستقلال والنشاط المهني لدى المرأة، بـ”الاستقلالية الموهومة”، كونه يشكل امتدادا للاستغلال، واعتبرت أن الاستغلال المالي صورة أخرى من صور العنف، أو حين تضطر المرأة إلى اللجوء للإنجاب كحل لسد الفراغ في علاقتها مع الزوج، وكبديل للهروب من مظاهر العنف المتعددة، بحثا عن “الوريث (الذكر)” بغاية تحقيق الامن المادي، ووسيلة لإنقاذ حياتها الزوجية، وإنجاب أبناء تكون وظيفتهم بمثابة مرساة لاستمرار الحياة الزوجية، لتختم هذا الفصل بطرح جملة من التعقيدات الناتجة عن التعدد، ومعاناة المطلقات، والأرامل، والإشكالات القانونية والنفسية والمجتمعية التي تلاحقهن.
تضمن الفصل الأخير والمعنون بــ”الدم والليل، اللذة والالم”، الإشكالات النفسية العالقة في ذهن الزوجة والمترتبة عن العلاقة الجنسية مع الزوج، إذ أن أغلب النساء يحتفظن بذكرى سيئة عن الليلة الأولى وما يصاحبها من عنف، وخوف، ناهيك عن قدسية هذه الليلة لدى المجتمع، والعادات المرافقة لافتضاض البكارة، إذ لا زالت تُعتبر هذه الاخيرة شأنا عاما يهم الجيران والعائلة كذلك، حسب تعبير بعض النساء المستجوبات.
تطرقت الباحثة كذلك لمسألة تحول الجنس لأداة مقايضة: الجنس للزوج، والمال للزوجة، مستعينة بتجارب نساء قائلات ما يلي: “المرأة النبيهة من تعطي زوجها ما يريد، وتحصل منه، في المقابل، على المال، والحلي واللباس”، وكذلك ” لو أنني منعته مني، فسوف لا تعييه الوسيلة للانتقام مني، وضربي في اليوم الموالي” أو “إنه واجب زوجي تقوم به المرأة، وفي مقابله تحصل على السكن والأكل”، مما يوضح أن العلاقة الجنسية في إطار الزواج تصبح بمثابة اغتصاب مشروع، ووسيلة للحصول على أساسيات العيش الكريم، وأي اعتراض من قبل المرأة من شأنه أن يجر عليها الويلات، مما يوضح أن الجنس لدى المرأة لا يعدو كونه ورقة رابحة، دون أن تكون لرغبتها أو رفضها أي اعتبار من قبل الزوج، ناهيك عن التنافس ببن الزوجات في حالة التعدد، لإرضاء الزوج جنسيا.
لتخلص في الأخير، بناء على نتائج عينة النساء المستجوبات، أن الجنس هو بمثابة “تجارة في الجسد الأنثوي”، فتكون المتعة للرجل، ونصيب المرأة هو الشعور بالإثم والعار، إضافة إلى بعض المشاكل الجنسية التي تستمر في صمت نتيجة انعدام الصراحة بين الأزواج.
يمكن القول إن هذه الدراسة هي تشخيص لواقع الحياة الجنسية للمرأة في مختلف مراحل حياتها. إذا قمنا بمقارنة بين الفترة الزمنية لصدور الكتاب والوضع الحالي، فسنلاحظ أن بعض الإشكالات جرى العمل على وضع مقتضيات قانونية لتجاوزها كإصدار قانون 103.13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء، وصدور أحكام قضائية، على ندرتها، فيما يتعلق بــ”الاغتصاب الزوجي”، حيث، في وقت سابق، كان من الصعب جدا الاعتراف بهذا النوع من الاعتداءات.
ينبغي استحضار أن بعض الممارسات التي تمس حقوق المرأة خصوصا داخل البيت من قبل الأسرة أو الزوج، تبقى متجذرة ويصعب انتشالها سواء عن طريق إصدار قوانين أو حتى بفرض عقوبات قاسية، ففي حالات كثيرة، لا تحقق هذه العقوبات الردع الكافي، لكونها تظل مرتبطة بمستوى الإدراك لدى الأسر.
ختاما، يبدو أن الأعطاب التي سلطت عليها الكاتبة الضوء، لا زالت قائمة في وقتنا الحالي، وبأشكال متعددة، وكأن من حق المجتمع أن يمارس الوصاية على أجساد النساء، فلا زال الزواج يعد “جنة الخلاص” من الأسر المتسلطة، ولا زال يُنظر للمرأة كأداة لتلبية الرغبة الجنسية للرجل، ولا حق لها في الاعتراض وإلا طالتها سيول من اللعنات، ولا زالت الكثير من النساء يتحملن العنف الجنسي ويرفضن الحديث عن ذلك، بغاية الحفاظ على “الأسرة”، وتحت ذريعة “حشومة”، هذه العبارة التي جعلت الحديث عن “الجنسانية النسائية” يكون همسا، بدل أن يكون بصوت مرفوع.
عموما، نستخلص أننا لم نتقدم فيما يتعلق بالجنسانية النسائية، إلا بخطى ثقيلة جدا، فرغم مرور 38 سنة على صدور أول طبعة من هذا الكتاب، إلا أن الكثير من الطابوهات التي تطرقت لها الباحثة سمية نعمان جسوس، لا زالت حاضرة، لتذكرنا بضرورة الاستثمار في التنشئة السليمة، وتعزيز الثقافة الجنسية، والمساواة بين الجنسين.
*فاطمة الزهراء حبيدة: طالبة جامعية