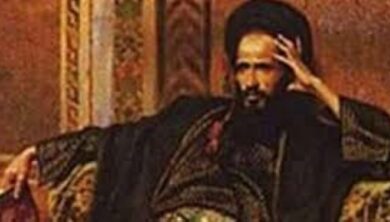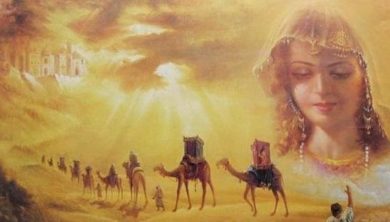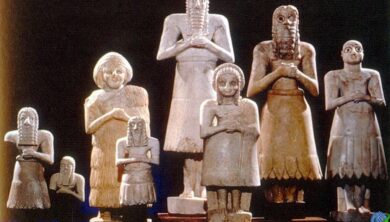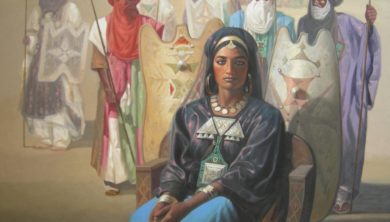محمد امحاسني: العلمانية في المغرب…. في نسختها التوفيقية
أحمد التوفيق، في هذا، لا يخرج عن القاعدة المألوفة لدى الإسلاميين قاطبة، والمنبنية على نفس الخطاب المهادن الذي يجهد في تقديم تراثنا الإسلامي للغرب، في صورة جد متقدمة ومتسامحة، بل أكثر علمانية من علمانياتهم. ثم ينكفئ إلى أهل الداخل ليطمئن الأتباع المخلصين إلى أننا على العهد باقون، وليحذر المخالفين من مغبة تصديق مزايدات اضررنا إليها مداراة لأهل الكفر، المتمكنين من رقابنا اليوم.
هي علمانية توفيقية، لأن الصدفة اقتضت أن يكون الدكتور التوفيق، باعتباره ممثلا رسميا للتوجه “العقدي” لدولة المغرب اليوم، من أوائل من يطرقون موضوع العلمانية في العقود الأخيرة، علانية، ومن داخل النسق، بجرأة محمودة على أي حال.
الميزة في هذا هي أن الدكتور، هو الأكثر قدرة على منافحة حراس العقيدة، من داخل مرجعيتهم، على التأصيل لمفهوم ما للعلمانية، يمكن أن يستجيب لروح العصر ولمستوى تطور البلاد، دون الإخلال بمقاصد الشريعة السمحة.
لأي مفهوم، لأية علمانية، أصّل التوفيق تحديدا؟ ذلكم موضوع آخر.
بدأت الحكاية حين بادر وزير الداخلية الفرنسي السيدَ التوفيق بالقول: “العلمانية تصدمكم”. وبصرف النظر عمن هو المعني تحديدا بضمير الجمع، هل هم المغاربة عامة أم المنتسبون إلى الشأن الديني فقط، فقد بادر الوزير المغربي إلى النفي، بله إلى التأكيد على أننا نحن المغاربة علمانيون أصلا.
رد، تقول القصاصة الإخبارية، ترك الوزير الفرنسي فاغرا فاه.
هل فغر الوزير الفرنسي فاه اندهاشا، لأنه كان يجهل أن المغاربة علمانيون، أم لأن تصريح التوفيق، كان مجرد رد انفعالي، وادعاء مجانيا لا يدعمه واقع الحال؟
على أي، فالدليل الجامع المانع الذي قدمه الدكتور على علمانيتنا هو أننا “نعيش حرية التدين”، رغم عدم وجود نصوص تنظيمية واضحة قاطعة في هذا الشأن.
وفي هذا إشارة واضحة، على كل حال، إلى أن المغاربة اليوم، لا يحتكمون إلى أية مرجعية دينية في تدبير المشترك بينهم، بل إلى قوانين وضعية محضة. قوانين مستلهمة من روح الأعراف والمواثيق الدولية.
اللهم إن استثنينا مدونة الأسرة، وما تستمده من أحكام مستلهمة من الشريعة. ليس إلا.
أي أننا في النهاية، نحيد الدين فعليا وعمليا في معظم معاملاتنا، دون أن نشير لذلك بالبنان في دستورنا وقوانيننا.
لذلك، يمكننا مبدئيا أن ندعي بأننا نحتكم إلى علمانية عملية بدائية، مقابل علمانيتهم الدستورية القانونية، المتواثرة منذ عقود.
علمانيتنا العملية نحن، تراكمت لدينا بفعل عقود طويلة، عشناها في ظل دولة مؤسسات مدنية، منبنية على مبادئ وقواعد سلوكية، خلفها لدينا الاستعمار الفرنسي، ولم تنجبها لنا أية دولة من دول الخلافة المتعاقبة علينا، قبل الاستعمار إياه.
لكن، لا بأس، ما دام الهدف في النهاية، هو من جهة، فتح نقاش عمومي هادئ ومستمر حول موضوع العلمانية كمطلب ملح داخليا، ومن جهة أخرى، إرسال إشارات مطمئنة لشركائنا الاقتصاديين على أن نظام حكمنا، يلائم قيم الغرب الحديثة، من حيث فهمه الخاص والمميز لمقاصد الشرع الإسلامي.
هي علمانية توفيقية، لأن الدكتور قال، من داخل “دار المخزن”، ما لم تجرؤ حتى أعرق أحزاب اليسار الثوري والليبرالي على مجرد التلميح له.
وقد أفحم الدكتور، في ذلك، حتى أقرب الجهات لمرجعيته، وأكثرهم قدرة على منافسته في شرعيته الدينية، حين أكد لعراب الإخونجة في المغرب، أنه لم يكن لذويه أصلا، أن يكونوا حزبا مدنيا اليوم، له ما لباقي الأحزاب، وعليه ما عليها، لولا تلك التقاليد السياسية والأخلاقية العلمانية التي يتنكر لها اليوم، والتي يحتكم فيها الجميع لإجماع مسبق، متفاوض ومتوافق حوله، قدر الإمكان.
والتوفيق محق تماما في هذا. إذ أن تلك التقاليد هي التي أفرزت لنا أحزابا ومجتمعات مدنية، وجعلتنا نحتكم للاقتراع الحر المنبني على الاقتناع الذاتي، وليس إلى أية شرعية أخرى، مقدسة كانت أم مدنسة.
صُعق العراب لردود الدكتور الواثقة والحاسمة، وانخرط في نوبة صادقة من الاعتذارات الصريحة والمبطنة، حين أيقن بأن لاءاته الاستعراضية البهلوانية، صارت تزعج اختيارات السلطة، الحداثية، والمتجاوزة بمراحل لقناعاته المهترئة.
صار منتهى أماني العراب، أن لا يكون قد خيب حسن ظن الدولة فيه، مرة أخرى، بما يضعف حظوظه في الانتخابات المقبلة.
فكان أن أمسك عن الجعجعة، تاركا لباقي الحساسيات الإخوانية والسلفية الأخرى وتفرعاتهما، غير المرتبطة بأية أجندة انتخابية، مشعل إذكاء النعرة الدينية، وتصوير العلمانية للعامة على وسائط التواصل باعتبارها كفرا وفسادا في الدنيا وخزيا في الآخرة.
ويبدو أن هؤلاء نجحوا في كبح جماح تصريحات الدكتور قدر المستطاع، إذ بادر الأخير نفسه، في تصريح تال، إلى الاستدراك والتصويب في مفهوم العلمانية الذي أسس له هو نفسه. فكان أن أضاف لشرط حرية التدين المفترى عليها، شرطا جديدا/قديما هو ضرورة التقيد بالكليات الخمس.
وهنا، انتهى محمد التوفيق وصارت التوفيقية (تجاوزا)، ترقيعية مثيرة للدهشة والسخرية.
الكليات الخمس في فقه المقاصد، عبارة عن ترتيب معين لأولويات مقاصد الشريعة، اختلف في ترتيبها الفقهاء، لكنهم أجمعوا جميعا على أن أولها وأولاها هو حفظ الدين.
فالدين هو “الحاجة الأولى قبل الحاجات الأخرى”.
والكليات الأربع التابعة، الأقل أهمية، هي ببساطة: النفس، العقل، النسل ثم المال.
أي بمنتهى البساطة: أن الحياة الدنيا بما حفلت، شأن تافه، ما لم يأخذ الدين حقه. سيان في ذلك إن قدمت أم أخرت إحداها عن الأخرى.
هرم ماسلو بالمقلوب.
علمانية بالجبة والعمامة.
أو لنقل: علمانية توفيقية، على غرار نظرية التعادلية التي أسس لها علال الفاسي (اقتباسا من تعادلية توفيق الحكيم) وروج لها “منظرو” حزب الاستقلال، سنوات الستينات والسبعينات في كل حملاتهم الانتخابية.
تعادلية بين العقل والروح، بين العلم والإيمان، ولم لا، بين العلمانية والإسلام.
تعادلية، لغريب الصدف، تلتقي منطقيا مع علمانية التوفيق في اشتراط الكليات الخمس إياها، وفي كونها جاءت كمحاولة للالتفاف على مطلب العلمانية الذي وجد له وقتها صدى واسعا في الحزب، ثم مع حزب الشورى والاستقلال المنشق عنه لاحقا، بقيادة محمد بن الحسن الوزاني، الذي اضطر إلى اعتزال الحياة السياسية عموما، بسبب مضايقات علال الفاسي وغيره، بسبب استماتته في الدفاع عن العلمانية حصرا.
هكذا، فتوفيقيتنا بعد التعديل، صارت ترى أن علمانيتهم لا تستجيب للحاجيات الروحية لمواطنيها، وترفض الإنفاق على الشؤون الدينية مثلا. ولهذا فهي علمانية متطرفة، تحارب الدين.
كلام في غاية الغرابة من مسئول في الدولة، يعرف يقينا بأن الدولة الفرنسية لا تحارب الدين ولا تدعمه، لأنه لا يدخل في دائرة تعاقداتها مع مواطنيها. ولأن الدولة ببساطة، ليست وصية على حيوات مواطنيها “الأخروية”.
لا شك في أن الدكتور قد تابع حفل افتتاح كنيسة نوتردام بعد ترميمها، ووقف عند الدور التنسيقي الذي اضطلعت به الدولة الفرنسية العلمانية الكافرة، بين مخلف المبادرات الداعمة لإعادة الترميم، من قبل تنظيمات دينية ولا دينية من مختلف بقاع الأرض.
الدكتور يمعن في التحريفية حين يتهم العلمانية بأنها “تُشعر بأنه بالعقل، يمكن أن نستغني عن الإله”. والحال أن العلمانية مجرد آلية للحكم، يقف مداها عند تدبير الحياة اليومية للمواطنين، ولا يتعداه، لا إلى الدعوة للاستغناء عن فكرة الوجود الإلهي ولا للتشبث بها. لأنها تتخذ نفس المسافة من كل المعتقدات، شخصية كانت أم جماعية، ومن كل الحساسيات، العرقية والدينية والجنسية وغيرها.
ولهذا بالضبط، تعتبر العلمانية صمام أمان لحرية الاعتقاد والتدين والعيش المشترك.
يكفي فقط، أن تصدق النوايا المعلنة للقيمين على شؤون الدين، في الحفاظ على قدسيته وروحانيته، وعلى الأخص في النأي بها عن مناورات السياسة وتأرجحاتها.
انتهى السيد التوفيق إلى التنكر من الأصل، لتوفيقيته الديبلوماسية، التي كان قد صدرها لوزير الداخلية الفرنسي، باعتباره جهة خارجية، وعاد إلى الأصل. إلى قبيلته الإيديولوجية، ليطمئنها إلى أن أصوليتنا باقية وستتمدد.
وهو في هذا لا يخرج عن القاعدة المألوفة لدى الإسلاميين قاطبة، والمنبنية على نفس الخطاب المهادن الذي يجهد في تقديم تراثنا الإسلامي للغرب، في صورة جد متقدمة ومتسامحة، بل أكثر علمانية من علمانياتهم. ثم ينكفئ إلى أهل الداخل ليطمئن الأتباع المخلصين إلى أننا على العهد باقون، وليحذر المخالفين من مغبة تصديق مزايدات اضررنا إليها مداراة لأهل الكفر، المتمكنين من رقابنا اليوم.
المأزق الحضاري الذي نعيشه اليوم في المغرب، يتجلى تحديدا في هذا التأرجح المأساوي، بين إرادة الدولة الواضحة في تحديث وعقلنة طرق اشتغال مؤسساتها من جهة، وبين الإصرار الأعمى لتيارات الإسلام السياسي على جر البلاد إلى غياهب التخلف، دون كلل.
الأدهى، أن يكون بعض المسؤولين الموكل إليهم أمر تنزيل سياسات الدولة، علمانيون لثمان ساعات يقضونها في المكاتب، وأصوليون في باقي تفاصيل حياتهم، في الساعات الستة عشر الأخرى.
يبدو أن طريق العلمنة والدمقرطة الحقيقيتين ما زال طويلا وشاقا.
إلا إن بادرت الدولة نفسها (وهذا ما لا أحلم شخصيا بإمكانية حدوثه راهنا) إلى سن قوانين ومقتضيات جديدة، تمتح من آخر ما توصلت إليه البشرية من نظم حديثة للحكم، وألا يثنيها في سبيل ذلك لا ضجيج المزايدين ولا المهرجين.
إسوة بما فعلته مع مدونة 2004 مثلا.