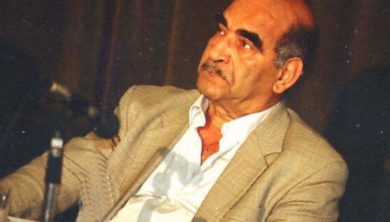زيارة قصيرة لمطبخ العلوم الإنسانية
هل بلغت العلوم الإنسانية اليوم مرتبة الخيمياء الاجتماعية؟ فالباحثون في هذا المضمار يفترض فيهم امتلاك معلومات خصوصية ونظريات عامة، وأفهام قاطعة وإيحاءات غير مكشوفة، تمنحهم سلطة وتسمح لهم باستعمال الوقائع تحت التأثير، لإبراز وجهة نظرهم.
تصدير المترجم

يعتبر هذا النص النقدي والتحليلي والنظري لـ بول باسكون (1932-1985) أحد النصوص النادرة في الكشف عن وضعية عالم الاجتماع وعن همومه وارتباطاته وعلاقته بالمعرفة والسلطة. فهذا السوسيولوجي المغربي (بالمولد والنشأة والجنسية) أحد مؤسسي علم الاجتماع المغربي بعد الاستقلال، وأحد رواده ورموزه.
وهو هنا يستبطن مَهمَّة عالم الاجتماع القروي ويسائلها، ويعريها في علاقتها بإنتاج المعرفة، وبالسياسة، وبالسلطة، كما باللغة وبالناس العاديين؛ الأمر الذي لم يقم به كثيرا إلا القليل من علماء الاجتماع بالمغرب، من قبيل عبد الكبير الخطيبي وحسن رشيق… إنها نظرة تحطم الأوهام وتبني علاقة جديدة للسوسيولوجي بعمله. وربما نظرا لهذا العمق، لم تفقد شيئا من وهجها رغم أن النص غير مؤرَّخ، ويبدو أنه قد كُتب في نهاية السبعينيات أو بداية الثمانينيات.
المترجم
مقدمة
يكمن هدف هذا العرض في تفحّص العلائق (أو عدمها) الموجودة بين الممارسة الفعلية والبحث، وجمع الوقائع من جهة، وبين تقديم النتائج في ما يُصطلح عليه بالعلوم الإنسانية.
وبما أن هذا العرض يدخل في إطار ما يسمى “لعبة الحقيقة”، فإني لن أخفي القارئ أن مرجعياتي هي مرجعيات علوم الجامد والحي، لا لأنني أعتقد أن مساعي العلوم الإنسانية عليها أن تشابهها (وهو ما لا أعتقده)، وإنما لأن ذلك تمرين صحي؛ مثلما أن الثقافة البدنية ممارسة صحية لمن يعيش حياة بيروقراطية.
إن الباحث، في تجربة كيميائية أو بيولوجية، يبدأ بالوصف الدقيق لبحثه. فالعلاقة بين نتائج التجارب وشروط تلك التجارب هي ما يبدو له أمرا وجيها. أما الخيميائيون فكانوا بالمقابل يخفون بحرص ممارساتهم ووصفاتهم بحيث كانوا ينشرون فقط نتائجهم؛ فلقد كان يفترض فيهم أن تكون لديهم “أسرار”، وتلك الأسرار هي ما كان يمنحهم حظوتهم. لقد كان ثمة زواج غريب يتحكم في أنشطتهم.
هل بلغت العلوم الإنسانية اليوم مرتبة الخيمياء الاجتماعية؟ فالباحثون في هذا المضمار يفترض فيهم امتلاك معلومات خصوصية ونظريات عامة، وأفهام قاطعة وإيحاءات غير مكشوفة، تمنحهم سلطة وتسمح لهم باستعمال الوقائع تحت التأثير، لإبراز وجهة نظرهم.
كل شيء يتم هنا كما لدى الخيميائي، إذ يتم تلميع الواجهة، وتقديم نتائج موثوق بها جدا، والسكوت عن النتائج المضادة، وبالأخص الإخفاء التام للطريقة التي تم بها التوصل إلى تلك النتائج. وفي أحسن الأحوال يتم الظهور بمظهر من توافق، أو بالأحرى، جهدَ للتوافق مع مواضعات خاضعة للتقنين (من قبيل الشواهد، والمصادر، وتقطيع النص، والتصميم، الإحصائات، وغير ذلك).
ثمة ما هو مخفي في سيرورة البحث في العلوم الإنسانية، وذلك ما أريد إبرازه.
1. وقائع تحت التأثير
تبدأ الفكرة التي يلزم تقديمها عن الوقائع تدريجيا في التبلور. فأركيولوجيا مساعي démarches الخطابات عن المجتمع تبيّن أن الدرجات الأكثر بدائية كانت هي الاستشهاد بالأعلام المشهود لها بالحظوة: “قال فلان، وقال الآخر عكس ما قال الأول، إلخ”. وقد كان المُضمر في الأمر هو أن هؤلاء الأعلام الأساتذة كانوا على علم بالأمور، وأنهم كانوا يعرفون النظر إلى الأمور. وفي الواقع، فإن الشيء الوحيد الذي نحن منه متأكدون هو أنهم كانوا يعرفون الكتابة، وأن كتاباتهم قد تكون بلغتْنا بمحض الصدفة، أي في ظروف بعيدة عن الصرامة العلمية. ربما كان طموح الكتابة والمرور إلى فعل الكتابة يبرهنان بما يكفي على الثقة البالغة بالنفس وبما يفكرون به؛ بحيث إن الشاهد لا يبرهن على شيء يُذكر إذا ما لم نتفحص شروط المرور من الملاحظة والرصد إلى الكتابة، وهو ما يعيدنا إلى مشكلنا الأساس.
إن رصد الواقع الجامد والحي أو المفكر، يقبل المقارنة بكونه لا ينفصل أبدا عن أحكامنا المسبقة ومضمراتنا قبل أن نبدأ في التحقق من الفرضيات. فالسيرورة تكون في الأول نفسية في صلب أفهامنا، وتفصح عن نفسها نادرا في منتهى تفكير بارد أو برهنة صارمة.
إن ما يمنح الانطلاق لملاحظة يقظة غالبا ما يكون ضربا من الدهشة، أو اللقاء غير المتوقع مع واقعة يصعب قبولها أو مفرطة في غرابتها أو صاعقة أو غير لائقة، تزعج أفهامنا، أو أنها ترضيها بشكل خفي لأننا نحس بأنفسنا محظوظين لأننا انتبهنا لها. انطلاقا من ذلك، سوف تغدو الملاحظات التالية تحت تأثير تلك الواقعة، ومعها أيضا طريقتنا في القراءة والسماع وجمع معلومات أخرى.
ونحن نعلم أن جمع الوقائع يكون تحت تأثير نظريات وأحكام مسبقة، وأن الرصد والملاحظة هما خدعة. وحدها السذاجة أو العقَدية الجامدة تجعلنا نخال أننا يمكننا أن نتجرّد حقا من مصالحنا الأخلاقية والفكرية أو المادية. وسأعود لذلك في ما بعد لتفحص أين تختبئ تلك المصالح حين تبدو كما لو أنها ليست هناك.
والنتيجة معروفة. فبما أن المرء لا يمكنه أن يقوم بوصف مكتمل (وهو مطمح مجنون ومستحيل)، يكون عليه الاختيار، أي -كما يقال- “حيثما تكون الرؤية واضحة”. يبقى أن نحلل آليات تلك الاختيارات. ما الذي يرشدنا ويوجهنا؟ هل هو حب الأصيل، والجديد أم غير المشهود؟ أم هو على العكس الحاجة للأمان وجمع الشمل، و”لقد قلت ذلك… ولقد لاحظته. أنا شخص باهر الذكاء، كنت أعرف ذلك”؟
إن الرصد والتحليل والحكم على الموطن الذي نوجد فيه يمكّن من أن نتساءل على الأقل عن الموطن الذي لا نوجد به.
إليكم عالما جغرافيّا في الميدان، يرسم خريطة الموقع على ورقة. وهو يشدد بشكل ما على المرتفعات والمنحدرات والمنبسطات méplats والمجْلدات. ثم إنه يلاحظ ما يوجد فوق الأرض: هنا غابة وهنا زراعات بورية وقربها أشجار الزيتون، وقطع أرض مسقية ومواقع القرى والطرق، إلخ؛ أي كل العمليات التي يمكن القيام بها أيضا بواسطة صورة جوية. وهو ما سيقوم به طبعا حين يعود إلى مكتبه. بيد أن ما رصده في الميدان قد يوجه إدراكه اللاحق، ومعه فك شفرة ما يبدو الأكثر وصرامة ودقة: الصورة الفتوغرافية. فهو مثلا قد لاحظ في الميدان بعض القطع الأرضية مزروعة بطريقة حديثة، وموجودة بطريقة خطية أو متعرجة. وسوف تنبثق بسرعة نمذجة تقول: ثمة مزرعة “شبكية” على طول مجاري الماء، ومزرعة “خطية” بزراعات متخالفة، ومزرعة “في شكل متعرج”. ولأنه سيسعد بالقيام بتمييز واضح في فوضى الواقع، سوف يجعل منه صورة مثالية. وسوف يقوم بشكل منهجي بالتمييز بين أشكال توزيع الأرض بين هذه الأنماط الثلاثة. وهو لن يتورّع عن أن يستخلص منها نظرية ثلاثية قابلة للتعميم على أنظمة سوسيو سياسية معينة، حتى بالعودة “للعصور الزراعية” القديمة.
هنا يتدخل ما يمكن أن نسميه الأثر البنيوي. فالعثور على البنيات في داخل الواقع يسمح بالتحكم فيه بفضل خطاطة معينة. وتكمن البنْيَنة في خلق فرق ومجموعات ووحدات يتم التعرف عليها بالتشابه في مجموعاتها الفرعية كما بالاختلاف والتمايز عن المجموعات الأخرى.
هكذا تتم إقامة عملية سيكولوجية تهدف إلى تعزيز الاختلافات مع ما هو داخلي من جهة ونقص الاختلافات مع ما هو خارجي من جهة ثانية. وثمة حركة مزدوجة للطمس الداخلي والتباين الخارجي. هكذا سيتركز الجهد على الحدود والتخوم. والأمر نفسه يسري على الطبقات الاجتماعية في علم الاجتماع والسياسة.
لنأخذ مثلا رسم احتلال الأرض والاختيارات البيانية للألوان لتقديم فكرة التقسيم المكاني وفي الآن نفسه انطباع تغير التضاريس والاستمرار. ففي هذه العملية يشتغل فن الكاريكاتور الذي ليس له علاقة وطيدة بالعلم، بل مع الفن، ومع خلق الصور والإشهار، أي بشكل ما مع البلاغة.
إنه خلق للصور يأتي لفرض رؤية ونظرية معينة.
وهي خطاطة تدعم نظرية، وتقطع الطريق على نظرية أخرى.
علينا دوما أن نسعى إلى تفحّص ما يُصنع في اختيار رسم ما، وخريطة ما، وبيانات رسم أو خريطة ما. وأنا أرى أن اختيار كلمة بيانات Légende اختيارا موفقا بشكل كبير[1].
2. منطق قصير النظر وتبسيطي
إن تفحص الكتابات العلمية في مجال الإنسانيات يفصح لنا عن هيمنة العِلِّية causalité التبسيطية بشكل مفرط، في الوقت الذي ينحو فيه خطاب العلوم البحتة إلى أن يغدو مركبا أكثر فأكثر. يبدو إذن أن الأمور في العلوم الإنسانية أبسط. ويمكننا القبول بذلك في الحالة التي تمسّ فيها التفسيرات مجموعات أقلّ تكون عواملها الثابتة أكثر. لكن، يتعلق الأمر بشروط معاكسة: أي بخطابات عن مجموعات تاريخية وجغرافية أكثر شسوعا، وعن موضوعات أوسع.
المتغير الأحادي
غالبا ما تكون العلّية المقدمة خاضعة لمتغيّر يعتبر سائدا ومهيمنا، وفاعلا “في آخر المطاف”، و”محدِّدا عميقا” للظواهر. إن هذا المتغير الأحادي يبدو مفاجئا في المجالات التي نعرف بالعكس أنها تابعة لعدد وافر من العوامل المتعاضدة والمتعارضة والمتوازية، إلخ.
لنأخذ على سبيل المثال موقع القرى في وادٍ معين. ثمة دراسات تعتبر أحيانا جدية تولي أهمية كبرى للتماسّ بين المنطقة الغابوية والمنطقة المزروعة، أو تتحدث عن “خط عيون الماء”، والترابط بين الأرض الكلسية والشستية، أو أيضا عن “الشبكية”، أي المسافة الأكبر للتجمع السكاني بالعلاقة مع بُعد أو قُرب الحقول الزراعية، إلخ. لكن القليل من الدراسات تسعى لتقديم:
1. جرد لكافة المتغيرات الممكنة؛
2. دراسة المؤشرات القادرة على تقديم طابعها الميداني؛
3. تطبيق منهجي وصارم لترابط يكون وجيها من الناحية الإحصائية؛
4. دراسة الحالات التي لا تفسّرها تلك المتغيرات (أي إدخال متغيرات أخرى لظروف طارئة أو من التاريخ…).
الخطية
ثمة نزوع متداول آخر، ينجم عن الهوْس (الفقر الفكري) السابق يتعلق بالنظرة الخطية لشبكة العلل، التي تتسم ببعض الحتمية.
بسبب “باء” التي هي سبب لـ “جيم”، الذي هو سبب لـ”دال”. أو “ألف” تعطينا “باء”، التي تعطينا “جيم” التي تعطينا “دال”، إلخ.
إن التسطيح (في مستوى ذي بعدين) لنظام العلل هو المنظور الأبسط الذي يسمح بسهولة بالتحرير (الكتابة)، والذي يختزل الخطاب في سلسلة من التفسيرات السهلة. فهنا، على الأقل، يكون المرء قد بلغ أفهام الناس والعرض سيكون من السهل القيام به.
إن الخطية، وبالرغم من أنها لا تفرض استحالة المراجعة، غالبا ما تفتح الباب أمام هذه النقيصة. من الأكيد أن التاريخ يؤكد لنا الانسياب اللانهائي للزمن واستحالة الرجوع للماضي. “فالماء الذي يمر تحت الجسر ليس هو الماء نفسه”.
والحقيقة أن التراجع أمر موجود، وعودة بعض الظواهر أمر وارد. فعملية تعرية التربة يمكن أن تتوقف لتستعيد نشاطها من بعد. كما أن أسباب ظاهرة حديثة قد تكون قديمة، وقد تكون تعطلت لقرون عديدة، ثم فجأة تعود للفعل نظرا لعامل بسيط وغير متوقع.
إغفال الفاصل الزمني
ثمة الكثير من الخطابات العلمية التي تتابع العلل إلى حد العبث، وتتناسى المدة الفاصلة التي يكون فيها للعلل معنى معين، وهو ما له الدلالة نفسها. لا شيء يكون تحت سلطة العوامل نفسها. فعلة ما في حالة مثبتة لا تكون ذات قيمة إلا في الفواصل ذات الطابع الكمي والكيفي من نظام معين للمتغيرات.
صحيح أن كل هذا يكون التصريح به أسهل من عرضه بالتفصيل. لكن، مثلا، في مجال العلوم الإنسانية القائمة، وأنا هنا أفكر في الديمغرافيا، نحن نعلم أننا يمكننا أن ندفع بالخطوط البيانية إلى ما بعد بعض الحدود، وبعض المدد الزمنية، من غير الانتباه إلى العلل التي تنقلب أو إلى تدخل علل أخرى.
النمذجة والنسقية
هناك اليوم تقليعة (والموضات أو التقليعات ليست دوما سيئة، فالبعض منها تكشف لنا عن عوالم لم نشك أبدا في وجودها) تتمثل في النمذجة modélisation وفي النسقية، وفي لعبة الفاعلين والسيناريوهات.
وأنا أعتبر هذه اللعبة أمرا دالا سواء في نجاحها أو فشلها. أوّلا لأنها تثيرنا بخصوص التعقد الذي نكون قادرين على الكشف عنه وتنظيمه؛ ثم لأنها تجبرنا على التنبؤ بالواقع ومن ثمَّ على تلقي قراره وحكمه. وهو حكم سيفرض علينا القول بأننا قد أخطأنا. فالنمذجة والمستقبليات قد تغدو عنصر صحة للعلم.
التجريد والتركيب والخطاطة والنظرية
ثمة فكرة مضمرة وضمنية دوما في العلوم الإنسانية تتمثل في تشجيع الباحث الذي ينطلق من الوصف نحو النظرية. وهو ما يعني أن هناك سلَّما (للمعرفة والحظوة) يبدأ من فحص الوقائع ويمر بالفرضيات ليبلغ التركيب وبلورة نظرية عامة.
يعتقد العديد من الباحثين أن الوصف هو الدرجة الأولى للمعرفة، أي مستواها الأدنى؛ وبأن الوصف يستثني التنظير، كما لو أنْ لا وجود للنظرية في أيّ وصف. إنه لَطبعا أمر خاطئ. فليس هناك وصف من غير نظرية ثاوية فيه أو معلنة. والوصف، من وجهة نظر التعبير، ليس سوى نمط لعرض النظرية. قد يكون هناك نمط وصفي ووقائعي للعرض النظري، ونمط مجرد أو نظري للنظرية. بالشكل نفسه، لا تستثني نظرية ما الوقائع بل تتضمنها. والمسألة تكمن في أيّ اختيار للوقائع بلورت.
يسود الاعتقاد بأن الوصف هو الأساس اليدوي لنشاط البحث والذي لا يحظى بالتقدير. فهو لحظة تعدّ ضرورية ومضنية ولا تتلقى الجزاء اللائق بها، بينما يُعدّ عرض النظرية نشاطا شريفا، أي أنه ذلك الذي يسمح ببلوغ ذروة العلم.
يسعى العديد من الباحثين، حتى المبتدئون منهم، إلى أن يستوطنوا حقل النظرية، تاركين مجال الوقائع بورا، رغبةً منهم في التسلق السريع لسلاليم النجاح وفي تذوق ملذات النخبة. إنهم، باختصار، يستعيدون وقائع الغير لكي يبلوروا منها النظرية، كما لو أن النظرية لا توجد مسبقا في تلك الوقائع.
كم من الأعمال تبدأ بالتعليق على المنظرين الكبار، خالطة بين العرض المدرسي (الذي يصلح للتدليل على أنهم قرأوا أمهات الكتب وفهموها) والعمل البحثي في حدّ ذاته الذي يتمثل في دراسة الواقع بالكثير من الحذر والحيطة.
أنا لا أنكر النقاش عن النظريات الكبرى. لكن، بشرط ألا يكون الهدف منه إقناعنا أن نظرية ما أفضل من أخرى، وإنما مساعدتنا على التخلّص من كل ما تخفيه عنا بسبب كونها قد تبلورت كنظريات. ليس هناك من نظرية حقيقية بتاتا. والقضية الأساس تتمثل في معرفة ما يجعلها خاطئة وعاجزة عن تفسير الوقائع التي تجري دراستها. ثم، إذا ما نحن فهمنا ذلك، وإذا ما كنا نعرف عن وعي أوْ لا أن النظريات تحجب عنا جزءا من الواقع، لأنها تسلط الضوء بشكل بالغ العنف عليها، سنكون مسلحين أفضل لرصد العتمة التي تحملها.
زدْ على ذلك أن التنوع اللانهائي للحالات والوقائع ينبغي أن يخضع للتنظير، ومن ثم سيتعرض للخيانة؛ وإلا، فإن أي تقدّم في التجريد لا يكون ممكنا. والمسألة تتعلق بمعرفة الهدف من ذلك. فهنا، تخضع العلاقة بين العلم والفعالية للنقاش. فالتجريد لا معنى له إلا في نجاعة إمساكه للواقع. والنظرية ليست كما يسود الاعتقاد خطوة نحو العلم، وإنما خطوة نحو الفعل، وشتان بين الأمرين. فمثلا، تسمح النظرية بالتدريس، إذ هي بيداغوجيا، وبلاغة. تمكننا النظرية من الفعل لأنها تقوم بالتصنيف والنعت والتنبؤ وتغطي على تردّدنا؛ أي أنها تسمح بالقيام بقرار. بيد أننا لسنا من البلاهة للاعتقاد بأن فعلا أو عملا يكون عملا حقيقيا. إنها لا تكون فاعلة إلا في تجمُّع صغير للحاجات وللشروط الراهنة. ويمكنها أن تكون خاطئة كليةً إذا ما نحن غيَّرنا عاملا من العوامل التي جعلتها فاعلة وناجعة.
البلاغة للحديث بوضوح
قلنا سابقا إن الوضوح يؤدي إلى اختزال الواقع وإلى خيانته في العموم. فهل يكون هذا علّة ليكون المرء غامضا. بالتأكيد لا. وذلك بشرط أن يظل واعيا بهذا كامل الوعي. ففي النهاية، من اللازم القدرة على تبليغ شذرات من المعرفة، أي شذرات قابلة للتراكم. والحال أن الغموض لا يسمح سوى بالتبديد. ثمة أسلوب في التواصل يعبّر عن طبيعة المسعى، وهو يكون دوغمائيا أو علميا. والتمييز لا يكون بين الوضوح والغموض، وإنما بين التقدم في التعبير عن التعقّد والتوكيد الوقائي والجنائي.
لقد ورثت الأطروحة في العلوم الإنسانية الكثير عن الأطروحة dissertation الفلسفية. وهو أمر صريح في العنوان نفسه: أطروحة= التوكيد على انحياز علمي أو أخلاقي. وفي الإنجليزية: Ph. D. التي تعني بالضبط الأطروحة الفلسفية. ونحن نعرف اقتصاد الأطروحة. فالمرء عليه أن يتحدث عن الخطاب السابق وعرضه وتفسيره. ثم إنه ينتقده ويفككه ويعْدمه. وبعد ذلك، يبني على الشظايا نظرية جديدة؛ ويقوم بعملية تركيب. والرهان يتمثل في السير بهذه المعركة إلى نهايتها بنجاح. وصيغتها الثلاثية (الأطروحة ونقيض الأطروحة والتركيب) عبارة عن محرك حقيقي ذي ثلاث أزمنة يمتح طاقته من خزان الوقائع والشواهد السابقة.
تهدف ممارسة الخطاب البلاغي إلى توكيد أساس أطروحة ذلك الخطاب ذاته. لهذا الغرض، نقوم بتعبئة الوقائع والأفكار التي تحطم الأطروحات السابقة واستدعائها. وهي تُختار مثل الشهود في المحاكمة. ولتعزيز القرار، يستدعى المساندون، ومعهم الوقائع المؤيدة. وغالبا ما لا تستدعى الوقائع والأفكار التي تشكك في خطابنا. وهو ما يعني دوما أن علينا أن نحقق الانتصار دوما. وهو أمر بالغ السهولة بما أننا نحن من يتحدث عنا.
الخلط أم التمييز؟
بيد أن الثقافات المختلفة لا تتعامل مع الخطاب بالطريقة نفسها، وهو أمر كان علينا توقعه. فلدى العرب، يتمثل الخطأ في الذوق العام في الفصل بين ما يوجد في وحدة الظاهرة؛ ولدى الغربيين يكمن الخطأ في الخلط. وليس ثمة من داع لجعل هؤلاء أو أولئك على حق. فثمة مسعيان نهائيان لهما غائيتهما واستكشافيان معا وشاذان معا. يمكننا القبول بتطور لوْلبي ينتقل من بلاغة لأخرى: أي أن نخلط، ونحلل ونخلط، وهلم جرا. وربما كان النجاح التقني يكمن في هذا التحليل وهذا التمييز المدفوع إلى حدّه الأقصى: فالطاقة الكهربائية لا تتولّد من التباعد الملائم لقطب ثنائي. وربما كان النجاح السياسي نفسه يكمن في امتصاص الأضداد، والحيلة الناجعة تكمن في التسويات. فالناس لا تتفاهم إلا بواسطة سوء التفاهم. بيد أن المحرك الكهربائي يلزم أن يجمع الأقطاب المتضادة، وعلى اللعبة السياسية أن تشتت التحالفات والكتل.
مبدأ عدم التناقض
تُدين النزعة الكلاسيكية التناقض. فالخطيئة بامتياز هي أن يسقط المرء في التناقض. في المساجلات والمشاحنات الخطابية أو المكتوبة، ما يكسر شوكة الخصم بالتأكيد هو إحالته لتناقضاته الذاتية. وأنا لا أدري لماذا سيكون التناقض خيانة للحقيقة لأنه خيانة للمنطق البلاغي والخطابي. فهل منطق البلاغة والخطابة منسجم مع منطق الواقع؟ وإذا كنا أحيانا ننتهي للإجابة بالسلب، فعلينا تغيير البلاغة. فليحْيَ التناقض إذا كان ذلك وسيلة لكي نفهم شيئا مما يدور حولنا.
نعم، الناس يتناقضون أحيانا؛ والفئات الاجتماعية تعتقد في شيء وتقول شيئا آخر وتفعل شيئا ثالثا. ومن بين الكائن المجرد والكائن المطلق والكائن المثالي، أفضّل التفكير في الكائن الواقعي ووصفه. فهو متناقض وغامض. وإني أطالب بالحق في التناقض، وفي التطور والتفكير في الأشياء المتوالية، التي تكون متوالية وحقيقية جزئيا، بحيث إن الواحدة منها لا تُبيد الأخرى فقط لأنها متعارضة معها.
كيف طبخت هذا العرض؟
طبخته فقط عن طريق استبطان نفسي. وبتفحص كيف أمارس أنا نفسي، وكيف أقوم بالانزلاقات بين المعنى والخطاب. وبالأدق، قمت بدراسة مقاطع من سلوكي نفسه خلال تنقلي في الميدان مع بعض الزملاء. وقد دوّنت حالات دهشتي وتوصيفاتي في دفتر اليوميات، كما استنتاجاتي المؤقتة ومواقفي وبهجتي بالعثور على حلّ لما يؤرقني، ثم سرّي (المخبوء) أي الشك الذي كنت أواريه عن نفسي.
في خلال ذلك، ظللت أدافع أمام زملائي عن الأطروحة الصغيرة لاستنتاجاتي السابقة، وأنا على علم، لا بشكل واع حقا ولكن بشكل غامض، أني كنت أحكي عموما قصة، لكنها قصة تستحق الحكي:
– لأنها كانت تحمل الجديد، بمعنى أنها كانت تصف وقائع غير معروفة، وبهذا الصدد فالتبرير كان تاما؛
– ولأني بإمكاني السطوع، أي الزيادة في رأسمالي الرمزي أو منعه من النقصان. وهو همّ لم يكن غائبا كلية، أو بالأحرى هو غالبا حاضر بشكل مركزي لدى المثقف، بحيث غالبا ما نتوقف عن الإشباع منه حتى العبث أو قبله.
– لماذا قمت بهذا العرض؟ كان ذلك بشكل ما رغبة في الحقيقة وفي تقدم العلوم. لكن بالتأكيد أيضا لكي أتابع صناعة الرأسمال الرمزي لنفسي. فحين يبلغ هذا الرأسمال التطور الكافي فإن خاصيته تكمن في النمو من خلال التشكيك في نفسه.
– وهو ما يؤول ربما إلى الاستنتاج بأن البلاغة الكلاسيكية هي الشكل البدائي للتعبير الفكري، وأن علينا أن نبتكر لأنفسنا بلاغة أخرى.
(لا يوجد تاريخ للكتابة في هذا المخطوط)
[1] نشير هنا إلى أن كلمة légende التي تعني البيانات التوضيحية التي توضع في الرسوم البيانية والخرائط، تعني في اللغة الفرنسية: خرافة وأسطورة. وباسكون يشير من خلال ذلك إلى الطابع الذاتي والبلاغي والمقصدي الذي يتخلل هنا وضع الخرائط والرسوم التوضيحية في المجال العلمي.