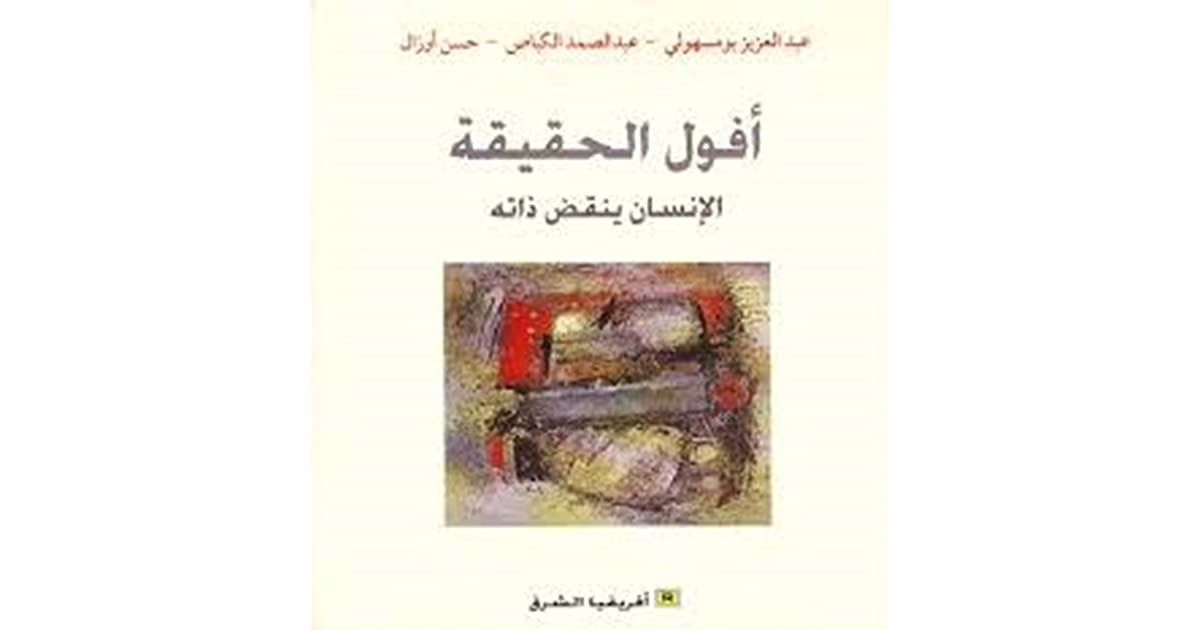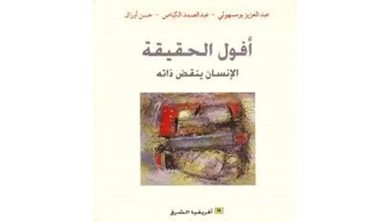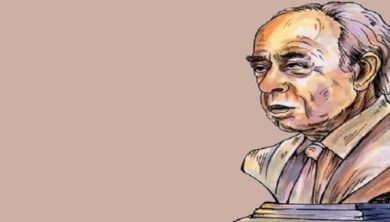حسن أوزال لمرايانا: الأهم ليس حصيلة ما قرأناه بل حصيلة ما عشناه في الحياة
في هذا الحوار، نستدرج فكرنا إلى تمرين جماعي مع المفكر حسن أوزال حول أسئلة القراءة والكتابة والحياة. حسن أوزال كاتب ومترجم مغربي، صدرت له العديد من الأعمال الفكرية والفلسفية، يهتم بالحياة ويؤمن بالفرد وباللحظة الآنية.
جاء هذا الحوار في سياق الاهتمام بالقراءة والكتابة باعتبارهما وسيلتان ضروريتان لتلقي مختلف العلوم والمعارف، في أفق تنوير الرأي العام والتشجيع على القراءة والكتابة والفكر والفلسفة، كنوافذ مشرعة على فضاءات الحرية.
• لك العديد من الأعمال الفكرية، نذكر منها “تضاريس فكرية نحو فلسفة محايثة” و”منطق الفكر ومنطق الرغبة”، ناهيك عن كتاب “تأملات فلسفية” الذي ترجمته مؤخرا للفيلسوف الفرنسي أندريه كونت سبونفيل، إضافة إلى مؤلفات أخرى.
كيف كانت بداية تجربتك في عالم الكتاب والفكر والفلسفة؟
ــ علاقتي بالكتابة واهتمامي بالفلسفة هي علاقة خاصة أكثر منها عمومية، أولا اعتبارا لمساري الدراسي العلمي (تخصص الجيولوجيا) المغاير تماما للمنحى الذي انشغلت به بعد الحياة الجامعية، أي المسار الفكري والفلسفي المحض. في خضم هذه المفارقة، كثيرا ما أستفسر عن إمكانية الجمع بين الطرفين، بحيث أن تشبعي بالعلم وبالمعرفة العلمية إن صح التعبير، هو الذي جعلني من حيث لا أدري أخوض في استشكالات فكرية فلسفية محضة، محاولا من خلالها أن أجيب عن سؤال واحد ووحيد يتعلق بقدري في الحياة. لست هنا بحاجة للتوكيد، على أن التساؤلات الفلسفية الأولى، برمتها، لم تزغ في شيء عن هذا المنحى، لأن الكائن العاقل لا يمكنه من حيث هو كذلك إلا أن يتساءل عن أصل الوجود ومن أين جاء وإلى أين يمضي، بل والتوقف عند هذا المسار الذي قد يطول أو يقصر ويتواجد بين عدمين (العدم الأول هو لحظة الميلاد والثاني لحظة الموت) استثمارا له كلحظة ثمينة استثمارا فلسفيا.
• كيف تمكّن القراءة والكتابة من استثمار هذه اللحظة الثمينة التي تحدثت عنها؟
ــ لعل استثمار هذه اللحظة الثمينة استثمارا فلسفيا، هو ما يجبرنا على أن نستوعب ما نكونه أولا نحن كذوات، قبل التوجه للآخرين؛ وذلك حتى يتيسر لنا أن نفهم هذه الورطة الوجودية التي انخرطنا فيها بشكل حتمي، كما يقول اسبينوزا، إذ ”لا أحد منا يختار حياته، بل كلنا مشروطون بشكل قبلي، بما نكونه أو بما نحن عليه”. لكن ما العمل أمام هذه الحتمية السبينوزية؟
هاهنا نلفي دور البحث عن مخرج يكاد يستغلق علينا أمره، ما لم نتسلح بما يقتضيه الحال من معارف. هذا ما تأكدت منه عمليا، وبشكل شخصي لما شرعت أقرأ سارتر، الذي مكنني من إيجاد مخرج خاص بي، بل كذلك نتشه الذي، في سياق آخر، يقر بضرورة إبداعنا لحريتنا الخاصة se créer liberté؛ عبر الاطلاع على المتون الكبرى، من عيار سارتر واسبينوزا وغيرهم من المفكرين والفلاسفة، وبذلك نفلح في إيجاد حلول لمشاكل فلسفية تخصنا.
بهذا الشكل أيضا، يتجلى واضحا أن الانخراط في القراءة والكتابة والفكر بشكل عام، ليس ولن يكون انخراطا مجانيا، بل هو انخراط محتوم على كل منا من حيث نحن كائنات بشرية تتساءل حول وجودها ومهمومة بأفقها وبمصيرها في هذه الحياة.
• إذا ما عجزنا عن تحويل المعارف التي نستنبطها من الواقع إلى سياقها العلمي والمعقلن، فهذا قد يشكل نتائج سلبية لفهمنا للواقع. فما الذي يمكننا قوله إذا ما أردنا الحديث عن الصعوبات المتعلقة بالحياة كلما انخرطنا في الكتابة والقراءة؟

ــ أنا في آخر مشواري في الحياة، أي في عمر يزيد عن الخمسين سنة، حيث تغيرت نظرتي، لا لإشكالية القراءة فحسب، بل للحياة أيضا، سيما وأنني لم أعد ذلك الشخص المراهق الذي كان يطرح تساؤلات بعينها تمتزج فيها الحماسة بالرغبة الفوارة. قد يكون، والحالة هاته، للنضج المعرفي والفكري دور يؤهل صاحبه للتقعيد لتصور نسبي ينفعه من حيث لا يدري. إلا أن ما نقرأه وما نكتبه وما نفكر فيه هو ناجم دائما عن عجزنا على التفكير أصلا؛ ذلك أن المرء الذي يدرك تفاهة الكتابة هو وحده من يستطيع تثمينها فعلا. آيتي في ما أوردته، أولئك الأشخاص من معارفي الذين أعلم علم اليقين ما يولونه من قيمة كبيرة للكتابة حد عجزهم طول مسارهم عن كتابة سطر واحد، فلم يتبقَّ لهم غير أن يزايدوا على كل من تفوق في هذا المجال كتابا ومؤلفين وانخرط في الكتابة بشكل سلس. ما يتناساه هؤلاء إنما هو كون الكتابة نتاج ما نحياه بأريحية تكاد تخلو من أدنى نزوع مفرط في الجدية. ينبغي أن ننظر للأشياء كنظرتنا للحياة ذاتها. ذلك أن الذي يحيا ليس هو الذي ينخرط في الحياة بجدية مفرطة، بل هو الذي لا يبالي بالحياة أصلا، إن لم أضف أنه الذي يتعامل معها بخفة. لذلك أيضا، تعطيك من حيث لا تدري، فهي دائما ما تفسح إمكانية العيش الرغيد أمام الكائنات الهامشية، بينما تقلص من حظوظ كل من لا يتقن فن اللعب معها واللهو على نحو ما يتعامل الطفل مع لعبته.
• خلال المعرض الدولي للكتاب، تم رفض مجموعة من المؤلفات وأخرى جرى سحبها. هل تعتبرون هذا تضييقا على حرية الرأي والفكر أم أنه يخضع لضرورة معينة؟
ــ ما نعيشه أو ما نحياه من عسر تداول الأفكار في في الدول العربية، أمر معهود ومعروف منذ زمان، لأننا في مجتمعات متخلفة لا يمكننا إلا أن نحيا على هذا الضرب. لكن، عندما يتم منع كتاب ما، فذلك بنظري ليس يرجع لما يحتويه من تصورات قد تفجر بنية المجتمع كما قد يخال البعض، بل لمجرد تدخل طرف ما في اللعبة. وفق هذه العملية البسيطة تثار زوبعة إعلامية، بدعوى أن هذا المؤلف سيقلب الدنيا رأسا على عقب. لكن الحقيقة أنهم بذلك فحسب يخدمون الكتاب وصاحبه، بحيث لن تمر بضع أشهر أو سنين حتى يحظى هذا الأخير بالشهرة التي لم تحظَ بها غيره من الكتب. يكفيني هنا أن أذكرك مثلا برواية الخبز الحافي لمحمد شكري، وما ناله من شهرة على إثر المنع الذي استفاد منه وجعل النص يحيا عبر الترجمة في لغات غير اللغة العربية. شكري لم يكن كاتبا يخل ببنية المجتمع أو هداما لصرحه كما تزعم التيارات المحافظة في المجتمع، بل هو روائي فسح المجال لنفسه كإنسان ليحكي عن معاناة تكبدها بمعيته العديد من البسطاء.
• أنتم كذلك تعرضتم للمنع في آخر ترجمة لكتاب الفيلسوف الفرنسي “أندريه كونت سبونفيل”. كيف تعاملتم مع هذا المنع؟
ــ أقدمت على ترجمة أول مقال من هذا الكتاب قبل ما يدعى بالربيع العربي. ولما كان عنوان المقال هو “الله”، أجبرت على تغييره حتى يستساغ نشره دونما مشاكل. هكذا، عدلته كالتالي: “سؤال الله وإشكالية الأنطولوجيا”. إلا أنني بالرغم من ذلك، تلقيت في يوم من الأيام رسالة من رئيس مجلة عربية مرموقة يتأسف فيها ويعتذر لي لعدم قدرته على نشر المقال، حتى لا يثير استشكالا رقابيا كما جاء على لسانه، واعدا إياي أن ينشر لي بحثا غير هذا البحث. في هذا الإطار إذن، جاء هذا المنع محفزا لي للانكباب على ترجمة الكتاب بأكمله، وكان فأل خير بالنسبة لي، لأنه مكنني من التعامل مع منابر فكرية أخرى بادرت مشكورة إلى نشر المقال دون تردد؛ ليلقى هذا الأخير صدى كبيرا. بغض النظر عن المضايقات التي يعاني منها المبدعون بالفعل على مستوى نشر أفكار معينة تثير حزازات هذه الجهة أو تلك، فقدر الكتابة لا يحيد عن هذا المسار وينبغي أن نقبل به كما هو.
• استحضارا لواقع الحال في مسار الكتابة، ما الذي يمكننا قوله إذا أردنا فهم وضعية الكتب والكتَّاب؟
ــ الأدب والفكر والفلسفة كثيرا ما يجيء معرقلا لمساراتنا في العيش. أعرف العديد من الكتّاب الذين انغمسوا في هذا العالم لدرجة يضيق منها حتى الإنسان العادي، لا لشيء إلا لأن هؤلاء أظهروا نمطا بئيسا من العيش لا يعكس بالفعل، لا قيمة الثقافة ولا قيمة الفكر الذي يدعون أنهم تشبعوا به. حينما نتعاطى الفلسفة، ينبغي أن نتعامل معها بنوع من الحذر وأن نبقي معها على قدر من المسافة الخلاقة، مدركين أن الأهم، كما يقول مونتين، ليس هي الكتب، بل هي الحياة أولا، فالأهم ليس حصيلة ما قرأناه، بل حصيلة ما عشناه في الحياة.
• علاقة بترجمتكم الأخيرة، كيف أثر فيك أندريه كونت سبونفيل كقارئ قبل أن تترجم كتابه تأملات فلسفية؟
ــ يمكنني أن أذكر بعض الإحصائيات التي جعلتني أنظر لهوس القراءة بنوع من الاستهزاء أحياناً. هذه الإحصائيات استحضرها أندريه كونت سبونفيل في حوار له وهو يتكلم عن نفسه لما ولج مكتبة المدرسة العليا للأساتذة التي تخيف وأنت بصدد الدخول إليها، نظرا لكونها تتيح في جناح الأدب فقط ما يزيد عن خمسمائة ألف كتاب. في هذا السياق، يتساءل سبونفيل: ما تراك تفعل إن تواجدت في المكتبة الوطنية التي تحتوي على ثلاثة عشرة مليون مؤلَّف، قبل أن يضيف أيضا: وما تراك تفعل إن تواجدت في مكتبة المؤتمر بواشنطن التي يصل عدد كتبها إلى حوالي عشرين مليون كتاب؟
لعل ما يرمي سبونفيل إلى توكيده في هذه الإحصائيات التي ينبغي استحضارها، حتى نتخلص من الادعاءات المعرفية وتبجح البعض بسعة الاطلاع، هو ما يشفع لي أن أشفق أحياناً على حال مجموعة من مثقفينا وهم يزايدون على بعضهم البعض، بعدد الكتب التي اطلعوا عليها، والروايات التي هضموها. يكفينا والحالة هاته أن نضعهم في قلب الواقعة ليشعروا بالإحباط: فهب معي أن أحدهم حالفه الحظ على مقاس سبونفيل الذي يتحدث عن نفسه ببساطة وبأريحية وبدون مزايدات، فدخل المكتبة العليا للأساتذة في عمر العشرينات. كم من كتاب سيكون قد قرأه طيلة حياته، إذا افترضنا أن العمر سيطول به لستين سنة أخرى، أي أنه سيعيش ما مقداره ثمانون عاما؟
يتوقف الأمر بطبيعة الحال على معدل القراءة، فإذا كان يقرأ كتابا في كل يوم وهو أمر مستحيل، فهو لن يقرأ سوى حوالي 4 في المئة من هذه المكتبة الأدبية البسيطة. أما إذا كان يقرأ مثل سبونفيل كتابا واحدا في أسبوع، فلن يقرأ سوى 1 في المئة من هذه المكتبة الهزيلة. هذا ناهيك بطبيعة الحال عن صعوبة القراءة حالما يجد المرء نفسه أمام كتب صعبة المراس من عيار “نقد العقل المحض” لكانط الذي استغرق فيه سبونفيل حوالي ثلاثة أشهر كاملة. بهذا الشكل، يتضح وضوحا قاطعا مانعا، أن الادعاء الذي يتداول إعلاميا في الدول العربية، فيه مزايدات كثيرة ومن الصعب استساغته. نحن نأخذ بعين الاعتبار هذه المعطيات الدقيقة؛ ومنه، ينبغي أن نتعامل مع الكتابة والقراءة بشكل آخر، على نحو ما تعامل معها كتاب حقيقيون من طراز مونتين وباسكال وآخرون، بحيث لا يتركون للكتاب سلطة يستطيع من خلالها أن يسطوا على ما تبقى من حياتهم، على اعتبار أن الأهم هو أن يغدو الكتاب في خدمة الحياة لا العكس.
مقالات قد تهمك:
- محمد شكري… الشحرور الأبيض، راوي طنجة وصاحب “الخبز الحافي” 2/1
- محمد شكري… الشحرور الأبيض، راوي طنجة وصاحب “الخبز الحافي” 2/1
- محمد زفزاف… دوستويفسكي الأدب المغربي!
- بين”الخبز الحافي” و”محاولة عيش”.. أدب مغربي لم يُهادن بؤس الواقع وانتصر للمسحوقين. (1/2)
- الأدب ”الجريء” بالمغرب… نقد خلاق أم مجابهة لمجتمع غارق في التقليدانية؟ 2/2
- مظفر النواب: هو الجوع أكبر من آبائنا الثائرين