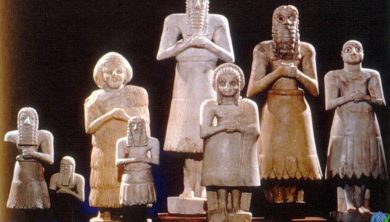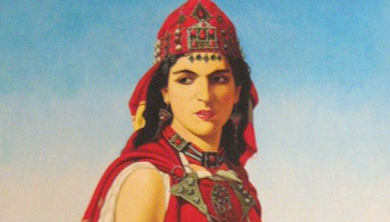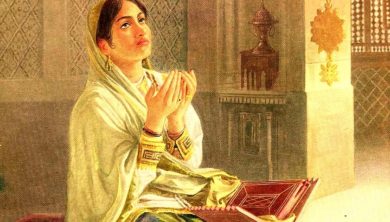حسن الحو: عن محاربة التفاهة والتيارات الهدامة. لماذا يُراد للمغرب أن يبقى في جُبَّة الفقيه؟
مشكلة التفاهة والتيارات “الهدامة” أعمق وأكبر من مواجهتها بالوعظ والإرشاد، وشيوعها دليل على فشل منظومات بأكملها، فالتافه، لو وجد تعليما عموميا يتساوى في جودته مع التعليم الخصوصي لما ترك في عقله نصيبا للتفاهة، والتافه لو وجد إعلاما رصينا يوجه ويبني، لما ارتمى في حضن وسائل التواصل الاجتماعي دون ضوابط، والتافه لو كُفلت له كل حقوقه الاجتماعية في عالمه الحقيقي، ولم يعان من شطط الادارات وخذلان ممثليه في المجالس التمثيلية، لما أدمن الغوص في عالم افتراضي يستجدي التكبيس واللايكات.
التشريع أو الإصلاح الذي يغفل التنوع الفكري والاجتماعي ولا يستند إلى أسس مدنية حديثة، لا يمكنه سوى أن يعمق الهوة بين الدولة والمجتمع، ويفتح المجال أمام الأصوليين لاستغلال الدين في الصراع السياسي والاجتماعي.
لا يكاد يُشرَّع قانون يحاول النزوع للتوافق مع القيم الإنسانية الكونية حتى تتعالى أصوات حراس العقيدة ومشايخ الإسلام متوعدة المجتمع بالخراب والعقاب الإلهي. عقاب، لو استطاعت لأنزلته بأيديها ونفذته ميليشياتها المسلحة، لكن الاستضعاف يجعلها تكتفي بالأمل والدعاء.
القوانين ليست وحدها ما يؤجج نيران التعصب والحمية الدينية في نفوس الإسلاميين، بل كل جديد في الأفكار والتكنولوجيات يثير ثائرة المُفتين ويستنهض هِممهم للتحريم والتكريه والتفسيق والتبديع، فتاوى غاية في الغرابة مُغرِقة في الجهل والتخلف.
قديما، حرّموا الراديو والمطبعة وركوب القطار والقهوة والمحاكم الوضعية، واليوم يحرمون تدريس نظرية التطور وتغيير القوانين بما يتلاءم مع انسيابية الزمن… كأنهم هم الأوصياء على المجتمع ومالكو الحقائق المطلقة. ولا فرق هنا بين مظهري التدين السلفي وبين من يَنسبِون أنفسهم للتجديد وفقه المقاصد، يتظاهر الجميع لنصرة الشرع الإلهي واحتكار الحقيقة، معضلة دينية جعلت الرقعة الجغرافية الممتدة من الخليج إلى المحيط تتشابه في تخلفها السياسي والثقافي وإفلاسها الاقتصادي والتكنولوجي…
ما ينبغي أن يَفهمه الإسلاميون والسياسيون الذين ينْظرون بعين الثبات للمنظومة الدينية، هو أن المجتمع المغربي تغير للحد الذي أصبح فسيفساء متعددة الألوان، ومشارب يجمعها الوطن، ويفرقها الفكر والانتماء والايديولوجية، فلا يمكن بحال من الأحوال أن يسوسها قانون ديني موحد أو تُفرض عليها، بالقهر والإكراه، آراء فئوية ضيقة، وأي تشريعات ينبغي أن تروم الحفاظ على تجانس المتساكنين في الوطن، وتنطلق من دراسات اجتماعية تحدد البنية الاجتماعية في كافة تمظهراتها فتعكس في قوانينها التعددية ومراعاة الاختلاف، فضلا عن الانسجام مع الأعراف الحقوقية الكونية.
كمثال على ما سلف: مدونة الأسرة في تعديلاتها المرتقبة، التي أثارت سخط المحافظين رغم أنها لم تراع التطورات الاجتماعية، وحقوق الأقليات، ولم تخرج في اجتهاداتها عن مطلق الأحكام الشرعية، والصواب الذي كان ينبغي المصير إليه، هو تبني مدونة مدنية تراعي كل أطياف المجتمع الذي يتشكل، بالاضافة للشريحة المسلمة الكلاسيكية، من شرائح أخرى كالمسحيين واللادينيين…
أشار التقرير السنوي لوزارة الخارجية الأمريكية (2024) حول الحريات الدينية الدولية إلى ارتفاع عدد اللادينيين في المغرب، مقدّرًا نسبتهم بحوالي 15%، مما يضع المغرب في مقدمة الدول “العربية”. وفي دراسة أجرتها عالمة الأنثروبولوجيا “لينا ريختر” في جامعة “رادبود نايمخن” الهولندية، أشارت إلى أن نسبة الملحدين في المغرب تتراوح بين 7% و15%.
تجدر الإشارة إلى أن هذه النسب قد تكون أعلى في الواقع، نظرًا لتردد البعض في الإفصاح عن معتقداتهم الدينية، بسبب الضغوط الاجتماعية التي تؤثر على استعداد الأفراد للتعبير عن معتقداتهم الدينية، ورغم ذلك فنسبة 15 % من التعداد السكاني البالغ 36.828.330 تعطينا رقما كبيرا: خمسة ملايين ونصف مغربي لاديني، أضف عليها 12000 تحولوا من الإسلام للمسيحية، وآلاف العلمانيين المسلمين الذين يرون فصل الدين عن الدولة في التشريع والحكم!! فكيف سيُفرض على الجميع قوانين مدونة إسلامية موحدة؟!!
المشرع الحكيم العارف بهذه الأرقام، المُلِمُّ بتغيُّر السياقات وانسيابية المجتمع وحتمية التطور في معناه الواسع، ينبغي عليه أن يجعل تشريعاته تنسجم مع هذه المعطيات حتى لا يُتَّهم بالفاشية والإقصاء، ويجعل المراجع التشريعية تتعدى المصادر الدينية وتسمو على الأعراف القبلية إلى أفاق إنسانية أرحب.
وما يقال عن المدونة يقال أيضا عن مقاربات محاصرة التفاهة في وسائل التواصل الاجتماعي، والتصدي للتيارات الفكرية “الهدامة”، فالتوجه مباشرة لمنظومة الأخلاق الدينية، باعتبارها المُخَلِّص من شيوع السلوكيات المنحرفة أصبح متجاوزا في ظل انتشار الوعظ الديني في كل مكان، وبرودة التفاعل معه، وذلك إما لعدم الايمان به من الأساس، أو اعتبار الانحرافات السلوكية مسألة شخصية يُتاب منها في وقت لاحق وليست مؤطرة بالواجب الأخلاقي الملزِم.
تصنيف التيارات الفكرية إلى هدامة وغير هدامة، ينبغي أولا التدقيق فيه، فلن نختلف حول اعتبار التطرف الديني تيارا هداما، لكن الدعوة للحريات الفردية ومناقشة الأديان والمطالبة بشيوع الممارسات الديمقراطية، ليست تيارات هدامة إلا إذا حكمنا عليها من منظور محافظ يخالف حيوية المجتمع، أو تماهينا مع نظرة الإسلاميين في تنظيرهم للأخلاق والثوابت، وهي فرصة سيستغلونها كما استغلوها في سبعينيات القرن الماضي، عندما أشعلوا شرارة ما سموه بـ “الصحوة الإسلامية”، التي لازالت آثارها السلبية مُرخية بظلالها على المجتمع إلى اليوم.
مقاربة تيار التفاهة والأفكار “الهدامة” لا ينبغي أن يحصر في فصيل واحد باعتباره الساهر على حماية الثوابت والضامن لاستمرارها، لأن ثوابت المملكة الخالدة ذات مقاصد وأطر تتسع لتشمل كل الاختلافات والايديولوجيات يكون فيها الله والوطن والملك مصطلحات دينية وسياسية وجغرافية تتأقلم لتوافق التغيير، فتوجهه وتحتضنه وفق منظور حقوقي منفتح، يلتزم بالقيم الإنسانية المتعارف عليه دوليا ويساهم في تطويرها، فالله والوطن والمَلك مِلك للمسلم والمسيحي واللاديني… وهي مصطلحات تؤطِر ولا تؤطَّر بإيديولوجيات وعقائد دينية منغلقة، لكن اعتبارها حمولة ثابتة لا تتغير لتساير التطور، وتجييش المنابر الاعلامية والدعوية لجعلها ذات مدلول واحد ونسق مكرر، لن يساهم إلا في مزيد من الجمود والانغلاق، وسيفتح الباب على مصراعيه للحركات الإسلامية للهيمنة على المجتمع وتأثيثه بأحكام دينية عتيقة تسير عكس حركة التاريخ، إن المراهنة على تخليق المجتمع وفق نظرة دينية أحادية حفظا للتوازنات السياسية لعبة خطيرة جدا، يصبح فيها المجتمع برميل بارود وقنبلة موقوتة تنفجر عند أي توتر سياسي، ليخرج المنظرون للخلافة الإسلامية من أجل تطبيق الشريعة وقطع الرؤوس والتشوف للغزو والفتوحات.
مشكلة التفاهة والتيارات “الهدامة” أعمق وأكبر من مواجهتها بالوعظ والإرشاد، وشيوعها دليل على فشل منظومات بأكملها، فالتافه، لو وجد تعليما عموميا يتساوى في جودته مع التعليم الخصوصي لما ترك في عقله نصيبا للتفاهة، والتافه لو وجد إعلاما رصينا يوجه ويبني، لما ارتمى في حضن وسائل التواصل الاجتماعي دون ضوابط، والتافه لو كُفلت له كل حقوقه الاجتماعية في عالمه الحقيقي، ولم يعان من شطط الادارات وخذلان ممثليه في المجالس التمثيلية، لما أدمن الغوص في عالم افتراضي يستجدي التكبيس واللايكات.
فالتشريع أو الإصلاح الذي يغفل التنوع الفكري والاجتماعي ولا يستند إلى أسس مدنية حديثة، لا يمكنه سوى أن يعمق الهوة بين الدولة والمجتمع، ويفتح المجال أمام الأصوليين لاستغلال الدين في الصراع السياسي والاجتماعي، كما أن هذا التشريع والإصلاح المنشودان لا يمكن أن يكونا بوصاية دينية جديدة، بل بترسيخ منظومة تعليمية قوية، وإعلام واعٍ، وتشريعات تحترم حقوق الأفراد وتضمن الحريات الأساسية، وإلا فإن المجتمع سيظل في دوامة من الصراعات العبثية، حيث كل فصيل يدّعي امتلاك الحقيقة المطلقة، ويُشرّع لنفسه الحق في فرض وصايته على الآخرين باسم “الثوابت” أو “الأخلاق”.