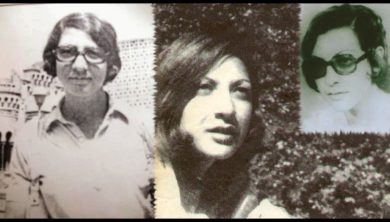سعيد الكحل: تعديل مدونة الأسرة يكشف عن معاداة الإسلاميين لحقوق النساء
الجمود الفكري الذي يشل عقول الإسلاميين، وعداؤهم المقيت والمزمن للمرأة، يجعلان من المستحيل انخراطهم في بناء دولة عصرية يتمتع فيها المواطنون بحقوق المواطنة دون تمييز جنسي أو ديني أو عرقي.
هم يعادون الحداثة والعصرنة والمساواة وما يرتبط بها من قيم وحقوق وثقافة.

منذ النشأة الأولى، في المغرب، لفرع تنظيم إخوان المسلمين والتنظيمات المتفرعة عنه وتلك المرتبطة به إيديولوجيا، لم يبادر الإسلاميون إلى رفع مطالبهم، إسوة بباقي التنظيمات الحزبية والنسائية، من أجل مراجعة مدونة الأسرة، أو تقديم تشريح لوضعية الظلم الاجتماعي والقانوني للنساء. كل ما قاموا ويقومون به إلى اليوم، هو التصدي للمطالب التي ترفعها وتناضل من أجلها مكونات الحركة النسائية والحقوقية مدعومة من الأحزاب الحداثية.
لهذا، نجد مواقف الإسلاميين والمذكرات التي تصدر عنهم، كلما طُرحت المدونة للمراجعة أو التعديل (1992، 2000، 2024)، كلها تسعى للالتفاف على المطالب النسائية بعد أن عجزت عن إقبارها بالتجييش ضدها، إذ تظل مدونة الأسرة هي البؤرة التي ينحصر فيها نشاط الإسلاميين بعدما تبنت الدولة القوانين المدنية في تدبير الشأن العام، بحيث لم يعد المجال يسمح لهم بمطالبة الدولة بتطبيق الحدود الشرعية أو فتح أسواق الجواري والإماء أو السماح بالعبودية، ذلك أن الدساتير المغربية، منذ الاستقلال إلى اليوم، وستظل إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، تنص على المساواة بين الذكور والإناث في الحقوق والحريات السياسية والمدنية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية، بل إن دستور 2011، خطا خطوة مهمة، من جهة، في الإقرار بسمو المواثيق الدولية على التشريعات الوطنية، ومن جهة أخرى في اعتبار الخيار الديمقراطي ثابتا من ثوابت الشعب المغربي حتى يغلق أي منفذ للإسلاميين للانقلاب على الديمقراطية والمطالبة بتطبيق أحكام الشريعة أو إقامة الدولة الدينية. ويشكل هذا الثابت صمام أمان يضمن مدنية الدولة في المغرب على النحو الذي يضمن دستور تركيا الكمالية علمانية الدولة.
1 ـ الوجه الحقيقي للإسلاميين
أـ رفض تثمين عمل الزوجة: يحاول البيجيدي التشويش على اللجنة المكلفة بالصياغة القانونية لمدونة الأسرة بعد التعديلات التي أجازها المجلس العلمي الأعلى، والتي لم ترض الحزب؛ بل كشفت عن تناقضاته، إذ يزعم الانطلاق من “المرجعية الإسلامية”، ومن “السعي الدؤوب لإنصاف المرأة والرجل على حد سواء، ورعاية المصالح الفضلى للأطفال والمجتمع، والحرص على تأمين أقصى درجات الحماية الحقوقية والاجتماعية والاقتصادية للأسرة المغربية باعتبارها الخلية الأساسية للمجتمع، والعمدة في تماسك وانصهار مكونات الهوية المغربية في بيئة أسرية آمنة مستقرة ومتماسكة”؛ وفي نفس الوقت يعبر عن رفضه، بشكل قاطع، تثمينَ العمل المنزلي للزوجة بحجة أن “تثمين الواجبات الأسرية أو المهام المنزلية مبنية في أصلها على العرف والتراحم والتعاون والتطاوع بين الزوجين وليس على التعاقد والندية بينهما”. وبهذا، يصر البيجيدي على شرعنة وتكريس استغلال النساء وكأن “المرجعية الإسلامية” لا تتحقق إلا بظلم النساء، وأن الأسرة لا تستقر إلا بحرمان الزوجة من حق كدّها وسعيها.
إننا أمام تناقض صارخ للبيجيدي؛ فهو يرفض أي “مسعى لإدخال الأسرة في منظور مادي أو مقاربة تسليعية”، في الوقت الذي يناهض فيه تثمين العمل المنزلي للزوجة. وليس غريبا على الحزب أن يتخذ هذا الموقف الرافض لتثمين جهد وعمل الزوجة وهو الذي ناهض بشراسة مطلب اقتسام الممتلكات الزوجية الذي رفعته الحركة النسائية وتبناه “مشروع خطة إدماج المرأة في التنمية”، وكرّسته مدونة الأسرة في المادة 49. لكن الحزب وفقهاءه اعتبروا هذا المطلب “أكل أموال الناس بالباطل”. أليس حرمان المرأة من ثمرات كدّها وعملها طيلة سنوات وعقود، أفظع أساليب “أكل أموال الناس بالباطل”؟ ومن تناقضات الحزب أنه يدعي التمسك بالفقه المالكي في التشريع للأسرة، بينما يرفض اجتهادات الفقهاء المغاربة في منطقة سوس وفتواهم بحق الزوجة في فيما تراكم من الممتلكات الزوجية، وهو ما يطلق عليه بحق “الكد والسعاية”.
ب ـ إنكار الواقع الاجتماعي: موقف البيجيدي الرافض لتثمين العمل المنزلي للمرأة يتأسس من جهة، على تبخيس عمل المرأة ومجهودها داخل الأسرة، ومن جهة ثانية، على إنكار التطور الملحوظ للأدوار الاجتماعية والاقتصادية للنساء، والذي جاءت نتائج الإحصاء العام للسكان سنة 2024 لتؤكده، حيث أظهرت ارتفاع نسبة الأسر التي تعيلها نساء من 16.2% سنة 2014 إلى 19.2% سنة 2024.
رغم هذا الواقع وما يفرضه من حقائق، لازال البيجيدي متمسكا بمفهوم “القوامة”: وهي بالنسبة إليه “قوامة حماية وصيانة ومسؤولية وأمانة وليست قوامة تسلط واستبداد. فالرجل هو المسؤول الأول عن أسرته والقائم بشؤونها والمكلف بتأمين حاجياتها، والمرأة مشاركة في المسؤولية في بيتها وراعية لأبنائها”.
بل إن البيجيدي يمعن في التعالي على الواقع وتجاهل معطياته، لما اعتبر أن مسؤولية الزوج “تبدأ مع بداية الرابطة الزوجية ولا تقف عند انحلالها، فيستمر الرجل في واجباته اتجاه أولاده بالإنفاق عليهم ورعايتهم وتستمر المرأة في مسؤولياتها بالقيام بمستلزمات الحضانة اتجاه أبنائها”.
تفسير مؤدلج لا يصمد حتى أمام الإحصائيات التي تضمنتها مذكرة الحزب، والتي كشفت عن أن قضايا النفقة المرفوعة أمام محاكم المملكة سنة 2021، بلغت ما مجموعه 29.665 قضية. فهل هذه القضايا رفعتها النساء أم الذكور؟ إنه رقم مهول وكارثي كان من المفروض أن يحرك الوازع الاجتماعي والإنساني والديني لقيادة البيجيدي قصد تغيير موقفها من المفهوم الذكوري “للقوامة” حتى تتعامل بواقعية مع المطالب النسائية.
ج ـ رفض الولاية القانونية للحاضنة على أولادها: إن النظرة التبخيسية للمرأة هي الموجهة لمواقف البيجيدي من المطالب النسائية المتمثلة في الملاءمة بين التشريعات الوطنية وبين الدستور والاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب. من تلك المطالب، إقرار المساواة في الولاية القانونية على الأولاد تطبيقا لما ينص عليه الدستور في الفصل 19: “يتمتع الرجل والمرأة، على قدم المساواة بالحقوق والحريات المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية، الواردة في هذا الباب من الدستور، وفي مقتضياته الأخرى، وكذا في الاتفاقيات والمواثيق الدولية، كما صادق عليها المغرب”. إلا أن الحزب يصر على خرق الدستور بـ”رفض المطالب المتعلقة بالمساواة الميكانيكية المطلقة بين الرجال والنساء في الزواج و أثناء عقده وفسخه، كإباحة زواج المسلمة من غير المسلم؛ والتسوية بين الرجل والمرأة في الولاية على الأبناء؛ أو التسوية في اقتسام الأموال المكتسبة أثناء الزواج بدون وجه حق”.
لكن، وبعد موافقة لجنة تعديل مدونة الأسرة والمجلس العلمي الأعلى على منح الأم الحاضنة الولاية القانونية على أبنائها، تقدم البيجيدي بمقترحات هدفها الالتفاف على التعديلات وإفراغها من مضمونها الذي يرفع الحيف عن الحاضنات؛ بحيث اقترح ــ الحزب ــ “الإبقاء على الولاية القانونية للأب مع منح الاختصاص لرئيس محكمة الأسرة (قسم قضاء الأسرة) -للبت في الطلبات المقدمة من قبل الأم الحاضنة في حالة وجود نزاع”. بمعنى جرجرة الأم الحاضنة أمام المحاكم وتعطيل مصالحها والمصلحة الفضلى لأطفالها التي جاءت التعديلات لتحميها وتضمن للأم حقها في ممارسة نيابتها على أبنائها. ولطالما ناهض البيجيدي ولاية المرأة على نفسها في الزواج، وطالب في المذكرة التي رفعها للجنة الملكية الاستشارية سنة 2000، بحرمان الثيب من حق الولاية على نفسهما الذي ضمنته لها مدونة الأحوال الشخصية لسنة 1993.
2 ـ شرعنة البيدوفيليا.
إمعانا في الاستغلال المادي والجسدي للمرأة، وتجسيدا للتعامل مع الأنثى كجسد للمتعة الجنسية، يطالب البيجيدي، في مذكرته بـضرورة الإبقاء ـ في المدونة ـ على الاستثناء الذي يسمح بتزويج الطفلات القاصرات في سن 15 سنة: “نرى ضرورة الإبقاء على هذا الاستثناء الذي يتلاءم مع الظروف الاجتماعية والاقتصادية للعديد من الحالات (خاصة الفتيات اللواتي يعانين من اليتم والفقر وعدم التمدرس) ويعتبر -الزواج وسيلة للاستقرار الاجتماعي بالنسبة لهن، أو بالنسبة للفتيان والفتيات اللذين يرغبون في الزواج المبكر ويتوفرون على الشروط الضرورية للزواج، مع العلم أن هذا الاستثناء يوجد في عدد من التشريعات المقارنة -سواء في الدول العربية والإسلامية أو في بعض الدول الغربية”.
لا شك أن البيجيدي لا يأخذ في الاعتبار النضج الجسدي والعقلي والعاطفي للفتاة حتى تكون مؤهلة للزواج ولا يشكل الحمل خطرا على حياتها. لهذا، لا يميز في الزواج بين الطفلة والمرأة البالغة. أما ما يزعمه الحزب من كون تزويج الطفلات ينقذهن من الفقر واليتم، فتكذبه القضايا المرفوعة أمام المحاكم من طرف أولياء أمور مطلقات قاصرات أنجبن أطفالا ولم يبلغن بعد سن 18 سنة.
وأدعو قيادة البيجيدي إلى مشاهدة حلقات برنامج “تحت الظل” للتعرف على معاناة الطفلات القاصرات خلال فترة الزواج أو هن مطلقات بأطفالهن. كما أحيلها على “الدراسة التشخيصية حول زواج القاصر” التي أعدتها رئاسة النيابة العامة وشملت الفترة الممتدة من 2015 إلى 2018، لعل البيجيدي يدرك مخاطر تزويج القاصرات ومآسيهن. فقد كشفت الدراسة “أن الزواج المبكر له تأثير مدمر على صحة القاصر المتزوجة وعلى أولادها، إذ أن الزواج المبكر يقترن بالحمل والولادة المبكرة؛ إذ اتضح من الدراسة الميدانية أن نسبة 82 % من القاصرات أنجبن في السنوات الأولى من الزواج؛ وأن”59,07 % من القاصرات يحتجن حين إقبالهن على الولادة إلى مساعدة جراحية، سواء عن طريق الولادة القيصرية، أو استعمال الغرز (شق العجان) نتيجة عدم اكتمال النمو الجسدي للطفلات المتزوجات. وأن أكثر من 14% من حالات حمل القاصرات تنتج عنها مضاعفات خطيرة كوفاة الجنين في الرحم، ووفاة الوليد والمواليد الجدد والإعاقة.
كما أن الزواج والولادة المبكرين يرتبطان ارتباطا مباشرا بارتفاع نسبة الأمراض التي تصاب بها القاصرات بعد الزواج، حيث تتوزع بين الأمراض الناتجة عن مضاعفات الحمل والولادة (55.25 %)، وأخرى ناتجة عن الوطء (3.50 %)، فيما أخرى ناتجة عن العنف الأسري (2.71 %) وأسباب أخرى (38.53 %). أما بخصوص العنف الذي تتعرض له القاصرات، فيتمثل في حرمانهن من أولادهن من طرف الزوج أو عائلته، في محاولة للضغط على القاصر أو ابتزازها، أو أنها تضطر إلى التخلي عنهم بـ “إرادتها” بسبب عدم قدرتها على الاعتناء بهم؛ وأن 22,30 % من القاصرات تعرضن للأنواع التقليدية من العنف: العنف النفسي، والجسدي، والجنسي، والاقتصادي، وأن 10,48 % من القاصرات تعرضن للطرد من بيت الزوجية. فالقاصرات، وفقا للدراسة، يعاملن كجاريات “مضطرات لخدمة أشخاص آخرين غير أسرتهن الصغيرة، بحيث أنهن ملزمات بالقيام بأشغال البيت لفائدة جميع القاطنين بالمنزل، وفي بعض الأحيان حتى لفائدة أشخاص يقطنون خارجه”. ومن ثم، أثبتت الدراسة أن “أهل الزوج يأتون في مقدمة المتسببين في العنف الأسري الموجه ضد القاصرات بنسبة (49.02%)، مقابل عنف الزوج بنسبة ( 46.69 %)، بينما بلغت نسبة العنف المرتكب من طرف شخص آخر (4.29 %).
أمام المخاطر الناتجة عن تزويج الطفلات، أوصت الدراسة باعتماد استراتيجية متكاملة “تهدف إلى محاربة الزواج دون سن الثامنة عشرة، انسجاما مع غاية المشرع الذي حدد سن الزواج في 18 سنة، ومع رؤية هيئة الأمم المتحدة التي جعلت من مكافحة زواج القاصر أحد الأهداف الأساسية للتنمية المستدامة في أفق سنة 2030.
لكن البيجيدي يتجاهل كل هذه الجهود التي تبذلها الدولة وهيئات المجتمع المدني، وكذا المخاطر التي تنتج عن تزويج القاصرات، فيصر على شرعنته. ولعل الإصرار على تزويج القاصرات هو تعبير عن حالة اضطراب نفسي مرفوقة بالعشق الجنسي للأطفال أو الولع الجنسي بهم. ذلك أن الدراسة التي أعدتها رئاسة النيابة العامة أثبتت أن فئة رجال التعليم وأئمة المساجد في مقدمة الراغبين في الزواج من القاصرات، في الوقت الذي يفترض فيهم أن يكونوا في طليعة المساهمين في التصدي للظاهرة. ولا غرابة إذن، أن يضفي الإسلاميون على هذا الاضطراب النفسي صبغة شرعية حتى لا يبدو شذوذا جنسيا، فيتعرضوا لوخز الضمير. فالمكان الطبيعي للقاصرات هو المدرسة أو مراكز التكوين المهني التي تؤهلهن لاكتساب مهارات حرفية تضمن لهن الولوج لسوق الشغل وليس البيت والإنجاب.
3 ـ أكل أموال الإناث بالباطل.
يعترف الحزب بالمظالم التي تترتب عن التعصيب والتي سماها “الانحرافات السلوكية التي لا يخلو منها مجتمع والتي منشؤها ضعف الوازع الديني والجشع المادي”. ورغم ذلك، يعلن “رفضه حذف التعصيب” بحجة أنه “ثابت بنص القرآن الكريم” مستشهدا بالآية القرآنية (يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ ۚ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ ۚ وَهُوَ يَرِثُهَا إِن لَّمْ يَكُن لَّهَا وَلَدٌ).
هذه الآية لا تنطبق إطلاقا على الأسر التي لها بنات ولم ترزق ذكورا. وقد اتفق المفسرون على أن الكلالة تعني مَن لا ولدَ له ولا والد، ليس له أبٌ، ولا أولادٌ، ولا ذرية، فيموت عن إخوةٍ، أو أعمامٍ. وكان أحرى بالبيجيدي أن يأخذ بالمعنى القرآني للفظ “الولد” الذي يشمل الذكر والأنثى على السواء كما في قوله تعالى }وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ{، أو في الحديث النبوي (إِذَا مَاتَ ابنُ آدم انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثٍ: صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ، أو عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ، أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ). فالشارع، عكس ما يزعم البيجيدي، لم يمنح للعصبة نصيبا في تركة من مات وترك بناتا. بل الثابت أن الرسول (ص) وصحابته طبّقوا قاعدة الرّد حتى يحصروا التركة بين أصحاب الفروض. وقد ذهب عدد من الصحابة والأئمة إلى القول “بالرّدّ”، ومن هؤلاء عمر بن الخطاب وعليّ بن أبي طالب وعثمان بن عفان وابن عبّاس وابن مسعود وجابر بن عبدالله [= جابر بن يزيد] وشريح وعطاء ومجاهد وتَبِعهم في ذلك الثوري وأبو حنيفة وأصحابه، وأحمد في أشهر الروايتين عنه. وقال ابن سراقة: «وعليه العمل اليوم في الأمصار». واختاره الزيدية والشيعة الإمامية. ويرى الحنابلة أنه يُردّ على كل أصحاب الفرائض على قدر ميراثهم إلاّ الزوج والزوجة. وهذا الذي سارت عليه دول عربية مثل تونس وسوريا واليمن والعراق، ودول إسلامية مثل تركيا والسنغال. لهذا، كان على الحزب أن يقترح تعطيل قاعدة التعصيب بدل الاقتراح البئيس الذي يستحيل تطبيقه: “يمكن ربط تفعيل استحقاقات العصبة وحصولهم على حقهم الشرعي من التركة بالقيام بواجباتهم الاجتماعية اتجاه أقاربهم وبعدم الإضرار بأرملة وبنات المتوفى إذا كان استيفاء الحق سيؤدي إلى تشريد العائلة أو التسبب لها في أضرار بالغة”. فمتى كان العصبة آكلي أموال اليتامى بالباطل سيتحمّلون واجبات الرعاية والإنفاق على ضحاياهم وهم يتكالبون على التركة بعدما كانوا يتربصون بالهالك قيد حياته؟
إن القرآن الكريم واضح في تحديد شروط الوارث وهي الرعاية والنفقة (وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ ۖ لِمَنْ أَرَادَ أَن يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ ۚ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۚ لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَّهُ بِوَلَدِهِ ۚ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَٰلِكَ). والمراد بقوله تعالى (وعلى الوارث مثل ذلك) إبعاد كل من لم تجب عليهم نفقة من يرثوه. قال قتادة والسدي والحسن وعمر بن الخطاب رضي الله عنه: هو وارث الصبي أن لو مات. قال بعضهم: وارثه من الرجال خاصة يلزمه الإرضاع، كما كان يلزم أبا الصبي لو كان حيا، وقاله مجاهد وعطاء: عليه مثل ما على والد الطفل من الإنفاق على والدة الطفل، والقيام بحقوقها وعدم الإضرار بها، وهو قول الجمهور. وقالوا: معنى الآية: وعلى وارث الصبي إذا كان [أبوه] ميتا ، مثل الذي كان على أبيه في حياته .ومعلوم أن المادة 197 من مدونة الأسرة تنص على أن (النفقة على الأقارب تجب على الأولاد للوالدين وعلى الأبوين لأولادهما طبقا لأحكام هذه المدونة). وبالتالي، لا تلزم العصبة من الإخوة والأعمام ولا أبناءهم بالنفقة على بنات الهالك. ومن ثم، فهم لا يستحقون الإرث لأنهم غير ملزمين بالنفقة كما تنص الآية الكريمة. ولعل سبب المآسي التي يتسبب فيها العصبة لبنات الهالك هو تحللهم من واجب الإنفاق بينما يحصلون على نصيب من التركة لم يساهموا في تكوينها ولم يتحملوا نفقة اليتيمات بعد وفاة والدهن.
4 ـ المقارنة الانتقائية.
من أجل دعم موقفه الرافض لمطلب منع تزويج القاصرات، لجأ البيجيدي إلى التشريعات المقارنة ليعزز مطلبه بالإبقاء على الاستثناء في مدونة الأسرة ليشمل ذوات 15 سنة حيث أورد في مذكرته “أن هذا الاستثناء يوجد في عدد من التشريعات المقارنة سواء في الدول العربية والإسلامية أو في بعض الدول الغربية”. لقد طالبت الحركة النسائية بالانفتاح على تشريعات دول عربية وإسلامية فيما يتعلق بالمساواة في الإرث وإلغاء التعصيب والسماح بالتوقيف الإرادي للحمل داخل مدة 120 يوما، لكن البيجيدي أصم أذنيه وتعامى عن التشريعات المقارنة ولم يَحْتَمِ بها إلا فيما فيه ضرر للإناث القاصرات. إن المقارنة السليمة تقتضي استحضار الاجتهادات الفقهية والتشريعات القانونية التي أخذت بها عدة دول عربية وإسلامية لرفع الحيف والظلم والتمييز عن الإناث تحقيقا للعدل الذي هو مقصد مركزي من مقاصد الشريعة. إن العدل لن يتحقق بأكل أموال اليتامى وتعريضهن للتشرد والضياع بتطبيق قاعدة فقهية فرضتها الأعراف القبلية والصراعات السياسية على الخلافة بعد وفاة الرسول.
ليكن البيجيدي منسجما مع دعوته إلى الاستفادة من التشريعات المقارنة فيما يخص تزويج القاصرات، فيدعو إلى الاستفادة من قانون الإرث المعمول به في تركيا حاليا. وهو نظام يعتمد مبدأ المساواة في توزيع التركة بين الإخوة الذكور والإناث، بحيث تتساوى حصصهم، كما ترث البنت منفردة أو مع أخواتها كل التركة إذا لم يكن معها أخ أو إخوة ذكور. ويُرتب، في القانون التركي، الورثة كالتالي:
. الأبناء والزوج أو الزوجة: لزوجة المتوفى أو لزوج المتوفية نصف الميراث، ويتم تقسيم النصف الآخر بين الأبناء الذكور والإناث بالتساوي.
. الأم والأب: حيث يرث الأبوان في حال لم يكن للشخص المتوفى أي أولاد.
. أشقاء المتوفى: ففي حال عدم وجود أي أولاد للمتوفى، ووفاة الوالدين، يحق لأشقاء المتوفى أن يرثوا نصيباً من أملاك المتوفى.
. الأجداد والأحفاد: حيث يرث الجد من ممتلكات المتوفى في حال غياب الوالدين، وأما بالنسبة للأحفاد، فهم في آخر مرتبة بالنسبة لأحقية الأقارب في الميراث.
وإذا لم يكن للمتوفى أقرباء على قيد الحياة، فإن جميع أملاكه تذهب للزوجة أو للزوج، وفي حال كان المتوفى غير متزوج، ولا يوجد أي ورثة على الإطلاق، فإن ممتلكات المتوفى تذهب للحكومة التركية.
وردّا على الترهات التي يقدمها البيجيدي من كون المساواة في الإرث وإلغاء التعصيب سيترتب عنهما تفكيك الأسر وخراب المجتمع وفساد الدين، فإن الواقع يثبت بالعين المجردة وبالإحصائيات أن المجتمع التركي، رغم اعتماده قانون أسرة عصري يقوم على مبدأ المساواة في الإرث ويلغي التعصيب، ظل يحافظ على استقراره، من جهة، ومن أخرى على تماسك الأسر وأداء الشعائر الدينية. الأمر الذي يفنّد مزاعم وتحذيرات الإسلاميين من “مخاطر” مقترحات الحداثيين على تماسك الأسرة واستقرار المجتمع. فحسب “معهد الإحصاء التركي”، فإن عدد المتزوجين سنة 2021 بلغ 561 ألفًا و710 شخص، فيما بلغ عدد حالات الطلاق 174 ألفًا و85 حالة، أي بنسبة 31%. ومقارنة بالمغرب، فإن إحصائيات وزارة العدل تبين أن عام 2021 عرف تسجيل 270 ألف عقد زواج، بينما حالات الطلاق بلغت 83888 حالة، أي بنسبة 31%، وهي نفس النسبة المسجلة في تركيا (نسب الطلاق عربيا: الكويت48% من إجمالي عدد الزيجات، حسب إحصاء وزارة العدل الكويتية. مصر بنسبة 40% حسب إحصائيات وزارة العدل المصرية وفي المركز الثالث والرابع، نجد أن كلا من الأردن 37.2%وقطر37%).
إن الجمود الفكري الذي يشل عقول الإسلاميين وعداؤهم المقيت والمزمن للمرأة يجعلان من المستحيل انخراطهم في بناء دولة عصرية يتمتع فيها المواطنون بحقوق المواطنة دون تمييز جنسي أو ديني أو عرقي. فهم يعادون الحداثة والعصرنة والمساواة وما يرتبط بها من قيم وحقوق وثقافة.