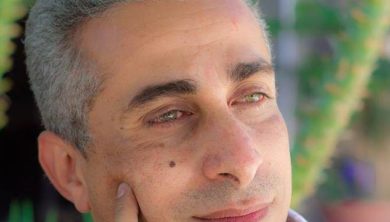جيل “Z”… مطالب الجيل الرقمي تسائل واقع بلد
جيل “Z” لم يعد يكتفي بمشاهدة صور إنجازات الدولة على الشاشات، بل يعيد قراءتها وتحليلها، ويعيد ترتيب أولوياته حولها، من الملاعب والمهرجانات الرياضية إلى المشاريع الكبرى، ليبرز الفجوة بين الرمزي والواقعي، ويضع السياسات العمومية الموجهة له تحت مجهر المراجعة
جيل “Z” يخرج اليوم من الشاشات إلى الشوارع، حاملًا صور الواقع الرقمي، ويعيد قراءتها في ضوء الواقع الملموس. الدولة، من جانبها، تبني الملاعب الحديثة وبنيات تحتية غير مسبوقة، وتستضيف التظاهرات الرياضية الكبرى، وتروج لاستضافة كأس العالم، لتبرز نفسها كصانعة للإنجازات وطموحًا وطنيًا متماسكًا. هذه الصور مصممة لإظهار الاستقرار والتقدم، لكنها في الوقت نفسه تسلط الضوء على الاختلاف بين الرمزي والواقعي.
المفارقة تكمن في أن نفس الصور التي صُممت لتسويق الإنجاز، تُستخدم اليوم من قبل جيل “Z” كأدوات نقدية: مقاطع الفيديو والمحتوى الرقمي يُظهر الفجوة بين المشاريع الكبرى وواقع الصحة والتعليم والتشغيل، بين الملاعب الفخمة والمستشفيات المزدحمة، بين الحملات الإعلامية الكبرى وأرقام الشباب الباحثين عن العمل، الصور التي كانت موجهة لإضفاء الشرعية على السياسات العمومية أصبحت منصة للتحليل والمقارنة، وساحة للنقاش العام.
هكذا، تتحول الرموز الرسمية إلى مرآة تكشف الواقع بدل أن تغطيه، ومنصة للتعبئة بدل أن تكون أداة ترويج. الجيل الجديد لا يستهلك الرسائل، بل يعيد إنتاجها ويصنع مفارقة مستمرة بين الخطاب الرسمي والواقع الملموس، بين الإنجاز الرمزي واحتياجات المواطن اليومية، ليعيد ترتيب الأولويات ويضع السلطة أمام اختبار مباشر لقدرتها على التكيف مع هذه الدينامية الرقمية التي توجهت إلى الشارع.
جيل “Z”: من النيبال إلى المغرب
خطورة هذا الجيل أنه ليس فقط فئة ديموغرافية، بل مرحلة عمرية، يصل فيها منسوب التواصل ذروته، فهم متأثرون بالعولمة والثورة الرقمية، ووجدوا في عالم سريع التحول، بالتالي فهم متقنون لآليات التعبئة الفورية؛ لكنهم، رغم ذلك، يفتقرون إلى رؤية استراتيجية، كي يكون احتجاجهم بفعالية أكبر.
التنظيم السياسي يحتاج: منطلقا، وتصورا، ثم برامج وممارسة كعناصر مترابطة، لفهم الواقع وصياغة بدائل لتغيير الواقع السياسي، غياب أحد هذه العناصر يجعل الاحتجاج هشا، وقابلا للالتفاف، أو تقوم الدولة باستيعابه.
غياب مشروع سياسي مؤطر هو نقطة ضعف وقوة في الآن ذاته. هي نقطة قوة لأن الدولة سيصعب عليها ضبط هذا التيار، وأمام امتحان لإيجاد خطاب يتماشى مع طبيعة هذا الجيل وتعدد خطاباته؛ ونقطة ضعف، لأنه قد يتلاشى، ويصبح مفتوحا على عدة احتمالات. بالتالي قد تكون حركتهم رمزية أكثر من كونها ممأسسة.
بنيويا، جيل “زد” يمثل تحديا مزدوجا للدولة، فهو قادر على تعطيل هياكلها مؤقتا، بفعل قدرته السريعة على التعبئة الرقمية، كما حصل في نيبال. لكن، في نفس الوقت، قد لا يستطيع بناء مشروع مستدام.
إذن، الدولة الآن أمام حركة “عفوية” لا تملك الآليات المناسبة للتفاوض معها. لذا، تستعمل المقاربة الأمنية وسياسة الرفض، كما أن خطابها، وإن كان إلى حدود اللحظة غائبا، فإنه سيكون امتحانا عسيرا، لأن مؤسسات الدولة هنا لا تتعامل مع تنظيم تقليدي تعرف بنيته والخطاب الموجه له وطرق احتوائه. إذن، فخطورة هذا الجيل تكمن في تضاد قوته، وغياب بوصلة سياسية، وضبابية المشروع المؤسس لها.
“ألتو سير”: إيديولوجية أللا إيديولوجي
كثيرا مما يُعاب على هذا الجيل بأنه جيل بدون إيديولوجيا، جيل رقمي محض، وصف بجيل التيك توك، تحكمه الشاشات لا المرجعيات. هي نفسها ادعاءات إيديولوجية، استنادا لأطروحة “ألتو سير” الذي اعتبر أن كل شيء ايدولوجية ، فهي لا تموت أبدا ولا يمكن تجاوزها؛ لأنها شعارات وممارسات وأنماط عيش، تحدد رؤيتنا لأنفسنا وللعالم.
رؤيتنا لهذا العالم تتجسد عبر المؤسسات المهيمنة. هي تفاصيل يومية، تقنع الناس بأنهم أحرار، بينما هم يعيشون داخل إيديولوجية خفية، “إننا، أنتم وأنا، كنا دائما ولا زلنا ذواتا، وهكذا نمارس دون انقطاع طقوس الاعتراف الإيديولوجي التي تضمن لنا أننا بالفعل ذوات فردية مرئية”.
إن ما يجعل الأفراد خاضعين للنظام الاجتماعي والسياسي، دون أن يشعروا بذلك مباشرة، هي هذه الإيديولوجية، التي تتجاوز كونها مجرد أفكار، إلى ترسيخ استمرارية الهيمنة الطبقية. هي لا تموت، بل متربطة بالوجود الإنساني، من خلال الإعلام والمدرسة والجامعة، وتوسيع دائرة الترفيه والاستهلاك، وإن لم نستجب لرؤيتها سنواجه بالمؤسسات القمعية كخط دفاعي ثان.
ابتعد هذا الجيل بالفعل عن النشاط السياسي، وهو ما يترجم في عزوفه عن الانتماءات الحزبية، والشعارات الصريحة من يسار ويمين ووسط. ولكن، مالم تنتبه إليه هذه المؤسسات، هو أن الأيديولوجية إن لم توجد ستستورد.
لقد عبر جيل “زد” عن نفسه، في الأيام الماضية، بإيديولوجيته الخاصة، رافضين كل التكتلات السياسية القديمة و”المتصدعة”. بلا “لحى وعمامات” الإسلام السياسي ولا “لافتات وصور اليسار”، وأطروا رؤيتهم إلى هذا العالم بإيديولوجية ناشئة، قوامها، الكرامة، الحرية، العدالة الاجتماعية، والانعتاق من الممارسة السياسية التي لا تشببهم، ومنفتحين على الخلفيات الثقافية والدينية والجندرية.
بمنطق “ألتو سير”، فما روج له بأن هذا الجيل بدون إيدولوجية، يخدم الإيديولوجية نفسها، لأنه أبقى الدولة مطمئنة، متوهمة أن الشباب صاروا خارج اللعبة السياسية والفكرية، وأثبتوا أنهم ليسوا صفحة بيضاء كما يُقال، وأن الايديولوجيا حاضرة دوما كما علمنا ألتوسير.
صورة الدولة وصورة جيل Z
خلال العقد الأخير، ركزت الدولة على إبراز صورة الإنجازات الكبرى، مستثمرة في مشاريع ضخمة مثل بناء ملاعب حديثة واحتضان تظاهرات رياضية دولية، كان آخرها الترويج لاستضافة كأس العالم. هذه المشاريع لم تُقدَّم فقط كبنية تحتية رياضية، بل كرموز على قدرة البلاد على منافسة الدول الصاعدة، ورسائل موجهة إلى الداخل والخارج بأن هناك مسارًا تنمويًا متماسكًا يعكس الاستقرار والطموح الوطني. في الخطاب الرسمي، شكلت هذه الإنجازات دليلًا على فعالية السياسات العمومية ونجاح الدولة في إدارة ملفات معقدة، حيث تحولت الصور ومقاطع الفيديو التي توثق لهذه الأحداث إلى مادة ترويجية تُبث عبر الإعلام التقليدي والرقمي على حد سواء.
لكن، في المقابل، واجه جيل “Z” هذه الصور بطريقة مختلفة، فبدل أن يستهلكها كما هي، قام بتفكيكها وإعادة نشرها على المنصات الرقمية مثل “تيك توك” و”إنستغرام”، مرفقة بتعليقات ساخرة أو مقاطع مقارنة تُظهر التباين بين هذه الاستثمارات الضخمة والواقع اليومي الذي يعيشه المواطن في مجالات الصحة والتعليم والتشغيل. فبينما تُعرض الملاعب كمؤشر على التقدم، تُظهر الفيديوهات البديلة مشاهد الاكتظاظ في المستشفيات أو الأقسام المدرسية المتهالكة أو طوابير الشباب الباحثين عن عمل، فيتحول المشهد الرسمي إلى خلفية تكشف اختلال الأولويات بدل أن تغطيها.
هذه المفارقة جعلت المنصات الرقمية ساحة مواجهة رمزية بين صورتين؛ الأولى رسمية، تحتفي بالمشاريع الكبرى وتسعى إلى ترسيخ سردية الإنجاز، والثانية شبابية، تفضح الفجوة بين الخطاب والممارسة. هكذا، تحولت الصور التي كان يُراد منها تعزيز شرعية الدولة إلى أدوات لتغذية النقد والاحتجاج. هذا التحول يعكس قدرة جيل “Z” على قلب الوظيفة الأصلية للرموز، حيث لم يعد المتلقي متلقياً سلبياً، بل فاعلًا يعيد إنتاج المعنى. بذلك، فإن ذات الأدوات التي استُخدمت للتعبئة الوطنية باتت اليوم آلية لتأطير نقاش عام، يضع السياسات العمومية تحت مجهر المراجعة ويكشف هشاشة السرديات الرسمية أمام دينامية رقمية لا مركزية.
بودريار الفكرة المضادة
تنبه جون بودريار منذ عقود إلى أن الواقع قد مات وحلت محله الرموز والصور. واقع أخر أسماه بالواقع الفائق، وهو عالم المحاكاة تختفي فيه الحقيقة، خلف الرموز والاستعارات، حتى لم نعد نعلم هل هناك واقع أصلا خلف هذا الفائض الصوري.
بالنسبة لجيل”Z”، واقعه ينتعش ويعيش في هذا الفضاء ”الواقع الفائق”، ولد وتربى في كنفه، حتى تجربتهم السياسية ولدت جنينة هنا، لكن ما لم يكن متوقعا، هو أن تنتقل من الخريطة إلى الواقع المادي. أي أن المحاكاة أضحت ميدانية.
المفارقة أن هذا الفعل السياسي خرج من بيئته الصورية العائمة، وتحول إلى أفعال جماعية على الأرض، أي أن الميديا كانت هي الرحم الذي أنجب هذه التعبئة الرسمية “ديسكورد” ، “انستجرام”، ”فيس بوك”، ”تيك توك” نحو الفضاء العمومي الكلاسيكي.
الواقع بُعث من جديد عبر “الرمز”، فما كان يخشاه بودريار، أن تضيع الحقيقة داخل هذا المد من الصور، الذي كان يعتقد أنه بداية ونهاية المطاف. ما نراه اليوم في العاصمة الرباط ومختلف المدن المغربية، هو دحض نسبي لأطروحة بودريال، فالواقع الفائق لم يبتلع الاحتجاج بل صار بوابة له.
هذا لا يعني القطيعة مع ما أسس له، فالواقع الفائق هو الذي يعيد انتاج هذه الاحتجاجات، ويعطيها شرعية نحو الفعل المباشر، وأضحى بطاقة تعريفية لهذا الجيل. هو انقلاب جزئي لطرح بودريار، المحاكاة لم تعد تلغي الحقيقة، بل تشعل نيرانها في الشوارع.
معنى ذلك، أن هذا الجيل، بدأ في عالم بودريار، لكن سرعان ما امتد نحو الشارع المغربي، مصطدما بالنخبة السياسية الحاكمة.
في مؤلفه ”المصطنع والاصطناع”، أخبرنا بودريار أن الصورة مرت في تاريخها بأربع مراحل كبرى: الصورة انعكاس لواقع عميق، الصورة تخفي وتشوه الواقع، الصورة تخفي فكرة غياب الواقع، الصورة بدون أي علاقة مع الواقع “مرحلة المحاكة الصرفة” والانفصال الكلي عن الأصل.
انسجاما وهذا الطرح، فما يقع الآن بدأ كصور تعكس الواقع، وكسر الحلقة في المرحلة الرابعة بالثورة عن هذه الدائرة المغلقة، لأن الصورة لم تبتلع الواقع بل استعادته، من الهاشتاج إلى الميدان، ومن المحاكاة إلى مواجهة السلطة في الشوارع.