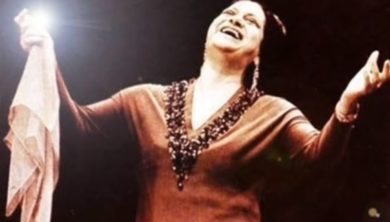قضية غيثة عصفور: ميشيل فــــــوكو وسَردية الشُّوهَة
كشفت قضية غيتة عصفور أن الجسد لم يعد ملكاً فردياً، بل ساحة تتقاطع فيها أنماط المراقبة والضبط، فالسلطة الحديثة لا تمارس حضورها عبر العقوبة المادية وحدها، بل عبر إشراك المجتمع في التشهير والوصم، حيث تحوّل العقاب في الزمن الرقمي من تقييد الجسد إلى تشويه السمعة، والفضيحة أداة للتأديب الجماعي،إنها سلطة تمارس من الدولة والمجتمع معاً، تجعل من كل جسد مشروعاً دائماً للمحاكمة.
واقعة اعتقال وإطلاق سراح الممثلة والمؤثرة المغربية غيثة عصفور، في الدار البيضاء داخل شقة، رفقة رجلٍ متزوّج، بناءً على شكاية من زوجته تتهمهما بـ“الفساد” و“المشاركة في الخيانة الزوجية”، أعادت النقاش حول علاقة السلطة بالجسد، وتحديد نوعها وحدودها، وكذا منسوب حرية التواجد في الفضاءات الخاصة.
هي واقعةٌ قد تبدو في ظاهرها حدثاً عابراً، لكنها تطرح الكثير من الأسئلة حول مدى شرعية تَدخُّل الدولة في الحياة الخاصة وحدود الحق في مراقبة الأجساد ومعاقبتها، وكذا موقع المجتمع كسلطة أُخرى تُدين وتشجب عبر ما راج في الفضاء الرقمي من تنمر وسخرية وأحكام جاهزة.
بذلك، صار الجسد موضوعاً مزدوجاً تحت مقصلتين: مقصلة القانون من جهة، ومقصلة الفضاء الرقمي من جهة أخرى.
يستعيد المشهد صدى أطروحات الفيلسوف الفرنسي ’’ميشيل فوكو’’ حول الجسد بوصفه ساحةً تمَارِس عليها السلطة انضباطها، ليس عبر العقوبة المادية وحدها، بل عبر شبكات المراقبة والتطبيع الاجتماعي أيضاً.
من فــــــوكو إلى الواقعة: كيف نفهمها؟
يُنبهنا ’’ميشيل فوكو’’ إلى أن المُستهدَف الوحيد في مجتمعات الحداثة هو الإنسان، في جسده أولاً، لأن السلطة تعمل فيه عملاً مُباشراً فتنحته وتُشكّله، كي يصير طيّعاً، قابلاً للامتثال داخل السجون وخارجها.
لقد لاحظ فوكو، أن هذا الكيان المادي ليس محايدًا، بل مختبرٌ تُترجِم فيه السلطة حضورها الأكثر كثافة، عبر مؤسساتها من السجون، والمستشفيات، والثكنات، والمدارس، التي رآها كأدواتٍ لإخضاع الذات كي تمتثل لأوامر النظام الاجتماعي والسياسي. ومن خلال هذه الشبكات المتعددة، تتم صناعة أجساد تحافظ على نفس نسق السلطة وأنماطها التي تراها ملائمة. يقول فوكو:
» المدارس تُقدم ذات الوظائف الاجتماعية التي تقدمها السجون والمصحات العقلية – وهي أن تُعَرِّفَ و تُصَنِّفَ وتُسَيطِرَ وتَضبِطَ النّاس «.
رغم أنه ركّز في تحليلاته الأولى على إقصاء المجانين وإيداعهم في المصحات العقلية، بوصفه نموذجًا لبداية المجتمع الانضباطي، إلا أن العامة بدورهم ظلوا موضوعًا دائمًا للمراقبة والوصم. فالمؤسسات الحديثة لم تُنشَأ فقط لحجز “الآخرين” الذين يُعتبَرُون خطرًا على النظام، بل امتدّت آلياتها لتطال الأجساد العادية، أجساد الناس جميعًا. فما يبدو شأنًا فرديًا أو معزولًا هو جزءٌ من سياسة أشمل، الكل في ظِلّها مُعرّضٌ للعقوبة والامتثال.
انسجاماً وهذا الطّرح، يمكن قراءة واقعة “غيثة عصفور” بأنها أكبرُ من تطبيقٍ حُرٍ لفصول القانون الجنائي (رغم قرار القضاء بحفظ ملفها وإخلاء سبيلها)، بل ممارسةٌ لسلطةٍ تُحاول تطويع الجسد وإخضاعه لمعايير الطاعة والامتثال، قبل أن تُمَدِّدَ أثرها إلى الفضاء الرقمي، حيث تضاعفت أشكالُ المراقبة والتأديب عبر التنمّر والوصم العلني. السلطة هنا ليست فوقية ومتعالية بمعناها الكلاسيكي المتمثل بمؤسسات الدولة فحسب، بل هي سائدة في كل مناحي الحياة وتخدم الخطاب السلطوي السائد. هي أفقية وليست عمودية، تختبأ مِجهرياً في المؤسسات والتشريعات والمجتمع..
من “معاقبة الجسد” إلى “تأديب السمعة”:
في الماضي، كان العِقاب مشهداً دمويا: تُقطع الرؤوس في الساحات، وتُعلّقُ الأجساد على المَشانِق، وتُجَرُّ بالأحصنة أمام الناس. لم يكن القتل هو النهاية، بل البداية لمشهدٍ تُعرَض فيه الجثة كخطابٍ للسلطة. لكن تمزيق الجسد أمام الحشود لم يعد مطلوباً اليوم، بل تطويعه في صمتٍ وحبسٍ وانضباط.
في العصر الرقمي، ظهر شكل جديد من التأديب: السُّمعة. التشهير الرقمي والوصم الاجتماعي والتنمر، كلها أدواتُ عقابٍ حديثة تضرب في العمق أكثر من السجن نفسه. فالخسارة هنا ليست حرمانًا من الحرية فحسب، بل خسارةُ صورة الذات أمام الآخرين، انهيار القيمة المجتمعية للفرد وعزله.
“الشُّـــــوهَة” و”الفْضِيحَة كْبْرَات” ليستا مجرد عبارات عابرة في التعليقات الرقمية وبعض التغطيات الإعلامية للملف، بل مفاهيمٌ اجتماعية تختزن داخلها آلياتَ التأديب الجماعي. فحين تُطلَق كلمة “شوهة”، يتحول الفعل الفردي إلى حدث جماعي مفتوح على التشهير والوصم. وحين تُردَّد عبارة “الفضيحة”، يُصبح تضخيم الواقعة نفسه جزءًا من العقوبة، إذ يتكفّل الجمهور بتحويلها إلى مادة لا تنطفئ.
حتى نقاش المسموح به هو هندسة اجتماعية تكشف على أن: “ما نسميه طبيعة بشرية هو جزءٌ من استراتيجية سلطوية، إنه ليس مُعطى فِطري بل بناء تاريخي”.
الفضاء الرقمي والفُرجة العقابية:
لقد وجدت بعض المواقع “الصحفية” في الحادثة هدية الموسم، لتكريس سردية “الشُّوهَة”، فتَمَدّدَ الخبر بسرعة إلى عمليات بث مباشر، وعناوين مُوّجهة دون احترامٍ “لقرينة البراءة”. بذلك، لم تقف الواقعة عند حدود محاضر الشرطة، بل تحولت إلى فرجة عقابية لمُضاعفة أثر العقوبة وتطويق الاسم والسمعة.
لا يتعلق الأمر هنا بمعاقبة الجسد بل بتعرية الفرد وتأديبه رمزياً لإعادة تشكيل السلوك من الداخل، الوصول إلى إمكانية “الرؤية الدائمة” لا من خلال القسوة الفورية وحدها، بل من خلال جعله موضوعاً للفُرجة.
تناسلت الشائعات مع تضخم الضجة، ورُبطت أسماءٌ لا علاقة لها بالملف، ما اضطر بعضهم إلى الخروج للعلن هروباً من “عدوى الفضيحة”، وخوفاً من التصفية الرمزية. فالتبرئة ومحاولات التبرئة هي رسالة إلى الآخرين: “سيحين دورُكَ إن خرجت عن الخط المرسوم ثقافياً وسياسيا”.
من منظور فوكو، هذا المشهد ليس انحرافًا عرضيًا بل آلية ضبطٍ نموذجية: مجتمعٌ يطلب من الأفراد تبرير ذواتهم وتقديم روايات/اعتذارات، ويُجبرهم على “تطويع” ذواتهم اتّقاءً لعين الجمهور. فالاعترافات التي كانت تُقام قديماً في الكنائس خلف ستائر الرهبان استُبدِلَ باعترافات أمام الشاشات إرضاءً لنظام السلطة ومعاييرها.
الفضاء الرقمي هو نسق تأديبي جديد لالتهام الفرد وتمزيقه، هو محاكمة افتراضية موازية للمحاكمة المادية. فكما كان الطاعون في القرون الوسطى ذريعة لإرساء أنماط المراقبة الصارمة حسب فوكو، بتقسيم المدن، وحصر السكان في بيوتهم، وإحصاء الأنفاس، فإنّ بعض الوقائع اليوم تُستثمر لتبرير تمدد عين المجتمع عبر الشاشات، بحيث يُعاد إنتاج “المراقبة والمعاقبة” بوسائل أكثر خفاءً.