المدارس الرائدة: هل تحول دور الأستاذ من مبدع إلى آلة؟
رغم كون المشروع لازال حديثا وغير معمم، ولا يوجد تقييم رسمي حوله، لكن الظاهر أن المدارس الرائدة، تخدم مجموعة صغيرة من الكفايات، كما تأخذ بالحسبان فقط ثلاث مواد.
ليبقى السؤال المطروح: ما مصير باقي الكفايات والمواد؟ وهل تحول دور الأستاذ من مُبدع إلى آلة داخل الفصل؟
للإجابة على إشكاليات حقيقية تعاني منها منظومة التربية والتعليم عموما، والمدارس الابتدائية خصوصا: من قبيل عدم التمكن من الكفايات الأساس، تباين المستوى بين المتعلمين، وجود تعثرات عميقة… لجأت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة إلى تبني مشروع المدارس الرائدة كجواب على كل هذه المشاكل.
هي مدارس تعتمد مقاربتين متداخلتين في التدريس: مقاربة التعليم وفق المستوى المناسب: (طارل) والتي عوضت محطة التقويم التشخيصي في المدارس العادية، بحيث كان يخصص أسبوع أو أسبوعان (حسب مذكرة كل سنة)، للقيام بروائز تروم الكشف عن مدى تمكن المتعلمين بداية السنة من المكتسبات الضرورية (المستلزمات) التي تم التطرق لها خلال السنة الفارطة، ليتم تقديم دعم استدراكي بعد تفييئ المتعلمين حسب مجموعة الحاجات (فئة المتحكمين، في طور التحكم، ثم فئة المتعثرين)، بغية جعل المتعلمين قادرين على الانطلاق بشكل جيد لتحصيل وبناء كفايات جديدة… لكن، هذه المحطة، حسب شهادات مجموعة من الأساتذة، وحسب تجربتي المتواضعة البسيطة، لا تعطي أكلها نظرا لمجموعة من الأسباب، أبرزها ضيق الوقت (أسبوع أو أسبوعان غير كاف البتة للقيام بمحطة التقويم التشخيصي)، بالإضافة لكثرة المواد والكفايات التي ينبغي التركيز عليها (نوعية وعرضانية: نذكر القارئ بأن الكفايات العرضانية هي الكفايات الخمس المبرمجة في الدليل البيداغوجي والمنهاج الدراسي: استراتيجية، تواصلية، ثقافية، منهجية وتكنولوجية).
الشيء الذي كان يقف عثرة أمام السادة الأساتذة للوقوف على الاختلالات التي سيؤدي تجاوزها تمكين المتعلمين من مواصلة تعلمهم بشكل جيد… بشكل أو بآخر، لم تُجب هذه الأخيرة عن مسألة التباين في المستوى، مما زاد من الهوة بين المتحكمين والمتعثرين في ظل منظومة تتغيا تحقيق الإنصاف وتكافؤ الفرص… لهذا، تتغيا مقاربة التعليم وفق المستوى المناسب (طارل) والتي تم تبنيها في المدارس الرائدة كما ذكرنا سلفا، تجاوز هذا المشكل، بحيث، يتم تخصيص شهر كامل لمعالجة التعثرات عن طريق ما يلي:
في بداية السنة، يتم تمرير مجموعة من روائز الموضعة في ثلاث مواد فقط وهي (اللغة العربية، الفرنسية، ثم الرياضيات). بعدها، يتم تصنيف المتعلمين في مسارات: (مسار مبتدئ، مسار الحرف، الكلمة، الفقرة ومسار الأقصوصة. هذا بالنسبة للغة العربية والفرنسية مع وجود فارق بسيط بينهما. ولتصنيف المتعلمين في مادة الرياضيات يتم الاعتماد على العمليات الرياضياتية؛ جمع، جمع بالاحتفاظ، طرح، جداء وقسمة).
تلي هذه المحطة أسابيع للدعم والمعالجة، حسب لبنات تتضمن أنشطة وألعابا، تحفز المتعلمين على الانخراط والمشاركة في التغلب على تعثراتهم، والمهم في هذه المقاربة؛ هو التعامل مع كل متعلم حسب حاجاته لا حسب مستواه (قد نجد في أسابيع الدعم متعلما من المستوى الرابع مع متعلم من المستوى الخامس والسادس في نفس الفصل، يتلقون نفس الأنشطة، نظرا لكون روائز الموضعة بينت بأنهم ينتمون لنفس مستوى الحاجة للدعم، أي بغض النظر عن مستواهم التعليمي الحقيقي، وهذا ما قد يعاب على هذه المقاربة).
المقاربة الثانية المعتمدة، أي بعد شهر كامل من التدريس وفق المستوى المناسب، يتم العمل بمقاربة التعليم الصريح. يتغيا هذا الباراديغم التعليمي تمكين المتعلمات والمتعلمين من اكتساب الكفايات الأساس (القراءة، الكتابة، الحساب) من خلال التركيز على المواد الأداتية الثلاث (العربية، الفرنسية، الرياضيات)، مع التطرق لباقي المواد الدراسية الأخرى والتي غالبا ما يتم إهمالها بسبب ضيق الوقت…
حجر الزاوية في هذه المقاربة: هي الخطوات المنهجية الخمس الواجب اعتمادها (التهيئة، النمذجة، الممارسة الموجهة، الممارسة المستقلة ثم التطبيق)، فمن الضروري جدا أن يُصرح المدرس خلال جميع محطات بناء الدرس، بالعمليات الفكرية المعتمدة أثناء القيام بنشاط معين.
بتعبير بسيط، ينبغي على المدرس أن يفكر بصوت مسموع في كل ما يقوم به، لكي ينتبه المتعلم للخطوات الإجرائية الواجب اتباعها لبلوغ الأهداف المسطرة. أثناء التدريس، يعتمد المدرس على شرائح جاهزة (PowerPoint)، الشيء الذي، مع الأسف، يحد من قدرته على الإبداع، أو التفكير في أنشطة جديدة غير روتينية، بل حتى إن المتعلمين يحفظون تحركاته، نظرا لكون الشريحة تُظهر المهمة المطلوبة منه ومن المتعلمين على حد سواء…
رغم كون المشروع لازال حديثا وغير معمم، ولا يوجد تقييم رسمي حوله، اللهم ارتسمات بعض السادة الأساتذة، لكن، الظاهر أنه يخدم مجموعة صغيرة من الكفايات، كما يأخذ بالحسبان فقط ثلاث مواد.
ليبقى السؤال المطروح: ما مصير باقي الكفايات والمواد؟ وهل تحول دور الأستاذ من مُبدع إلى آلة داخل الفصل؟







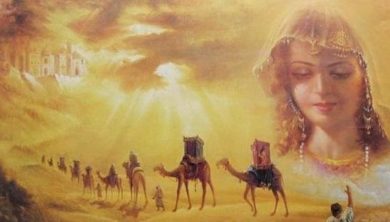
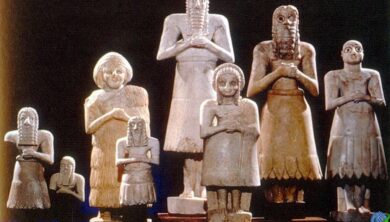
👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻