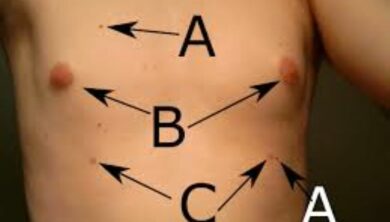تاغنجا: حكاية الفتاة التي أحبها إله المطر… أعراس الاستسقاء عند الأمازيغ
تعود طقوس تاغنجا في شمال إفريقيا، إلى قرون بعيدة قبل دخول الإسلام.
تاغنجا، هي حكاية الفتاة التي أحبها إله المطر، فصدته، لتتحول مع الوقت، إلى طقس مركزي في حياة الأمازيغ، وعنوانا لاستسقاء المطر والأمل في مواسم الخصب والرخاء.
حكاية… لازالت الكثير من تفاصيلها، حاضرة في ممارسات المغاربة إلى اليوم.
حين تمسك السماء عن الجود بحبات مطرها، وتتلاحق سنوات الجدب والقحط، لا تجد ساكنة الدواوير والمناطق النائية حلا روحيا غير استجداء السماء “بتاغنجا”، علها تجود بغيث يبعث في الأرض اليباب الحياة، ويبعث الأمل في النفوس الظمأى.
حافظ هذا الطقس الشعبي على استمراريته وديمومته كلما اشتدت سنوات الجفاف، في مناطق كثيرة يعتمد ساكنتها على النشاط الفلاحي فقط. هذا بالرغم من التأثيرات التكنولوجية التي حولت الأجيال الجديدة عن الاهتمام بهذه الطقوس، إضافة إلى عوامل أخرى يتداخل فيها ما هو مجتمعي بما هو سياسي وديني.
على بعد خمس عشرة سنة من حلم ما تزال مشاهده طازجة في ذاكرتي، أستطيع الآن استرجاع ما ترسخ من أجوائه المحمومة التي تفرد لها الذاكرة البعيدة مكانا أبديا للإقامة.
في إحدى القرى المتاخمة لمدينة الصويرة، حيث دأبت أسرتي على قضاء جزء من العطلة الصيفية بين أحضان “البلاد” في “الدار الكبيرة”، حيث مجمع الأهالي والأصدقاء، تعود الناس على إقامة محافل سنوية للتضرع إلى السماء في حالات الجدب والجفاف.
استبدت عشية ذاك اليوم بأهالي القرية سعادة كبيرة، قبل أن يتوجه الجمع الغفير من النساء والأطفال إلى مسجد القرية، حاملين “تاغنجا؛ عروس المطر”، وحناجرهم تصدح بأزجال وابتهالات شعبية دينية وأهازيج لطلب الغيث، فيما ترنو العيون إلى السماء متطلعة إلى “العرش العظيم” لتشديد عزائم الفلاحين وسقيهم بالغيث المدرار.
يعود الاحتفال بـ”تاغنجا” في شمال إفريقيا، إلى قرون بعيدة قبل دخول الإسلام، حيث كان أمازيغ شمال إفريقيا أقرب وجدانيا للأساطير ولتأليه الطبيعية، والتعبد برموزها وتقديس خيراتها؛ وعليه، فـ”تاغنجا”، وفق الأساطير القديمة، هي عروس إله المطر “أزار”.
حسب القصة الشعبية المتوارثة في هذا الصدد، فــ”تاغنجا” فتاة عذراء، بالغة الحسن والصفاء، تأسر الناظرين إليها وتسلب خيالاتهم وعقولهم، وتسحر روحهم. دأبت “تاغنجا”، كما تشير الأسطورة، على التوجه إلى وادي القرية العذب حيث تقيم، قبل أن يراها “أزار” وهو “إله المطر”، فيسحر برقتها وعذوبتها، ومن تمة يسعى لجلبها إليه والظفر بقلبها. لكن “تاغنجا”، حياء منها وحشمة، وخوفا على شرفها وسمعتها داخل القرية، ترفض “أزار” وتتركه.
سيعصف الحزن والغضب بقلب إله المطر بعد هذه الواقعة، ليقرر تدوير خاتم يده المتحكم في الفصول تجاه سنوات القحط والجفاف؛ وهو ما حصل.
سيجف نبع الماء في القرية، وستبور الأراضي، وسيقل القوت، وتنعدم مصادره. على إثر هذا، تقوم نساء القرية وأناسها بالتوسل لـ “تاغنجا” لقبول حب إله المطر، وستوافق هذه الأخيرة رحمة بقريتها، وعليه قدمت “تاغنجا” بلباس أنيق عروسا وقربانا لإله المطر، الذي تلقاها بفرح، وأدار خاتم يده مرة أخرى، لكن هذه المرة… تجاه سنوات الخصب والخير.
لم يقتصر الاحتفال بطقس “تاغنجا” على المناطق والقرى الأمازيغية فقط، بل همَّ كل المناطق، وجرى الاحتفال به على نطاق جغرافي واسع، شمل في بعض الأحيان الحواضر.
يقابل “تاغنجا” باللغة العربية، المغرفة الخشبية، وهي آنية مطبخية تُعتَمد في المغرب في سقي الكسكس عادة وأطباق أخرى. وعليه، فمراسيم الاحتفال بهذا الطقس، تبتدأ بتحضير عروس المطر من القصب، ويتم تزيينها بأدوات التجميل المحلية مثل الكحل، ثم إلباسها أزياء شعبية أنيقة. تعقد في يدها المغرف الخشبية، كرمز للسقي، وأعواد الحبق، للدلالة على الخصوبة والطبيعة.
يجتمع أهالي القرية في نقطة معينة في القرية، يتم الاتفاق عليها بشكل قبلي، يتقدمهم حامل “تاغنجا” والأطفال الذين يحملون ألواحهم القرآنية متقدمين الجمع الغفير، بينما تصدح حناجر النساء بأهازيج شعبية، من قبيل:
“تاغنجا تاغنجا الله يجيب الشتا”،
و”السبولة عطشانة سقيها يا مولانا”،
و “تاغنجا حلت راسها يارب فك خراسها”.
تختلف بعض الحيثيات في طقوس الاحتفال بين المناطق، فهناك من يتجه إلى مسجد القرية لقراءة “الفاتحة” ورفع الدعاء إلى الله وبعدها العودة إلى البيت، وهناك من يزور قبر أحد الأولياء الصالحين، إن وجد في القرية، تيمنا لمباركة مساعي الفلاحين، تم هناك من يجتمع على قصاعي الكسكس التي يتم تحضيرها بعد جمع تبرعات أهالي القرية خصيصا لذلك.
في مناطق أخرى، يتقدم الجمع الغفير من يحمل عروس المطر “تاغنجا”، إضافة إلى شخص يسوق عجلا أو بقرة، تقدم كهدية للسماء لتستجيب للدعوات الظمأى. تشير بعض الروايات التاريخية إلى أن بول الدابة، سواء كانت بقرة أو عجلا، في الطريق إلى الذبح، يعد بشارة فرح وخير قادم، سيسقي القرية ويزيل آثار البوار والجفاف من على أراضيها.
إضافة إلى هذا، تتكلف إحدى السيدات بجمع السكر والتمر والحلوى والتين المجفف (الشريحة) في “طْبْق”، تضعه فوق رأسها، ليتم توزيعها لاحقا على الأطفال والنساء، أو يتم تناولها بالإضافة إلى كؤوس الشاي في محيط المسجد أو الولي الصالح إن تواجد قبره قريبا.
قبيل انتهاء مراسم الاحتفال، يضع أهالي القرية المغرفة الخشبية في آنية ماء كبيرة، تتجه كل العيون لرؤية ما سيحدث، إذ يعد طفوها فوق سطح الماء دليلا على قبول تضرعاتهم، وعلامة على قرب نزول المطر. في حال وقوع العكس، يكون ذلك إنذارا بعام آخر من الجفاف.
لا يخلو هذا الطقس من لهو الأطفال الصغار، إذ يعد حضورهم إلى جانب الكبار أمرا في غاية الأهمية والضرورة، بالنظر، حسب الاعتقاد الشعبي، إلى شدة “قربهم من السماء والملائكة” التي لا ترفض لهم طلبا أو دعاء. يلهج الصغار ببضع آيات قرآنية غنموها من تعلمهم بمسجد القرية أو المدرسة، قبل أن يتحولوا إلى اللعب بالماء ورش النساء والصبايا به، وهذا لا يضير أيا من الناس، إذ يعد عملا مستحبا، لا يمكن أن تنتهي طقوس “تاغنجا” المباركة من دونه، فيكون آخر ما يختم به اللقاء، ليعود الناس إلى أيامهم المقبلة مبتلين، والأفئدة معلقة أمانيها على الدعاء والاستغفار للخلاص من الجفاف الذي يؤرق النفوس، وإحياء الأمل للانبعاث في الحياة من جديد.
“تاغنجا” والحداثة
أثرت العوامل التكنولوجية والعولمة الثقافية على درجة تشبث المغاربة بطقس “تاغنجا”، خاصة الجيل الحالي؛ وهو جيل معولم نشأ في خضم الثورة الرقمية القوية التي يعيش العالم على وقعها. هذا الأمر عبر عنه رشيد بوزيدي، الأستاذ المحاضر في التاريخ والتراث والآثار بالكلية المتعددة التخصصات في تازة في تصريح لـ”مرايانا”، إذ لخص عوامل تراجع الاحتفاء بتاغنجا في الطفرة الرقمية بشكل خاص.
وأشار إلى أن “تاغنجا” هي مفردة أمازيغية، شأنها شأن مفردات كثيرة لازالت دارجة في القاموس المغربي، وهي عادة ضاربة جدورها في القدم، كما أن تواجدها لا يقتصر على التراب الوطني فقط، بل تحتفي بها كذلك دول أخرى في شمال إفريقيا مثل الجزائر وتونس، كما أنها من العادات القبائلية التي كانت تشارك فيها النساء والأطفال والرجال؛ وتصاحبها، في الغالب، مجموعة من الأمور منها بعض الحفلات الدينية الأمازيغية. ذات المتحدث أضاف أن الناس يتوجهون خلال قيام هذا الطقس إلى مجموعة من العيون ومنابع المياه التي جفت بالمنطقة. “لا تقتصر “تاغنجا” على طلب الغيث، بل حتى إنشاد الخصوبة كي يزداد منتوج الأرض” يقول رشيد بوزيدي.
الباحث أضاف أن “تاغنجا”، كغيرها من الأعياد الأمازيغية التي دأب فيها الناس على إقامة حفلات تجتمع فيها العائلات، وتهيئ الفطائر والتين المجفف، بدأت تندثر شيئاً فشيئا، وهذا راجع إلى عدة عوامل، ضمنها التطور التكنولوجي، فالأجيال الجديدة المعولمة لم تتشبع كفاية بالطقوس الثراثية القديمة، وهو ما قد يساهم في زوالها مع مرور الوقت.
إضافة إلى التأثيرات الخارجية والتغيرات المجتمعية، هناك أيضا، حسب رشيد بوزيدي، عوامل الاستعمار وسياسة التفرقة بين العرب والأمازيغ التي انتهجها الاستعمار الفرنسي في مرحلة من المراحل، كما أن هناك عوامل سياسية ودينية أيضا، فالتشبث بالعادات والتقاليد الدينية الإسلامية، أسهم بشكل كبير في تراجع هكذا طقوس، حيث كانت تعتبر خارجة عن الإدارة الإلهية، فبات طلب الشتاء يتم عبر صلاة الاستسقاء فقط.