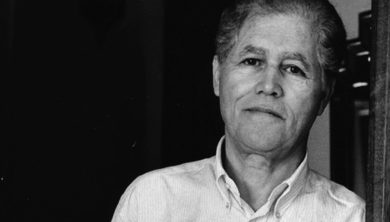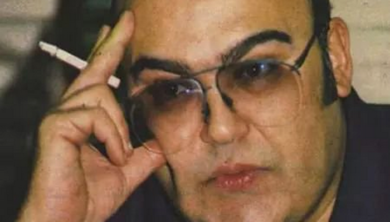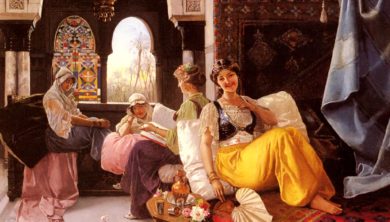الحداثة من جديد… حين يجتاح العلم حياتنا
الحداثة لا يمكن الاستفادة من مكاسبها والظفر بمزاياها، والمتمثلة في المردودية والنجاعة… ولا يمكن أيضا التعامل مع أسقامها وأوجاعها والمتمثلة في هتك الحدود وهدر المعنى، وبشكل نقدي، إلا بالعودة إلى جذورها المتمثلة في العِلم. فهي بمثابة نظرية كبرى لا يمكن مجابهتها إلا بنظرية كبرى أخرى لم يحن وقتها بعد، ولسبب وجيه يتمثل في نجاعة العِلم لحد الساعة. فكل النقد المقدم للحداثة، في عالمنا الناطق بالعربية خاصة، مازال يضرب الأحزمة الواقية ولم يبلغ بعد النواة.
1- الحداثة هي الأسلوب العلمي حينما تعمم:
لنبدأ أولا بإزالة اللبس حول تعريفنا للحداثة باعتبارها: “الأسلوب العِلمي الموجه لكل قطاعات الحياة”، فالمقصود بالضبط هو: أن الحداثة هي تلك الحركة الدؤوبة، وغير المنقطعة في تقليد الروح العلمية، وتوجيهها نحو مناحي الحياة، فالعالِم الذي نجح، بدءا من القرن السابع عشر للميلاد، في اكتساح الطبيعة واستنطاقها، وكشف حجبها، وإرغامها على نثر الأرقام من جوفها بنجاح فائق، محققا من خلال طريقته هذه، النجاعة والمردودية، قد أغرى مجالات الحياة جميعها بالسير على المنوال نفسه. وما العلوم الإنسانية إلا شاهد على ذلك، حيث انفجرت بدورها، في القرن التاسع عشر للميلاد، منشدة درب العِلمية، رغم الصعوبات كلها في مباشرة الإنسان، مُعلنة أن فهْم الكائن البشري في جوانبه “اللامادية” لن يكون ذي جدوى دونما تقليد العلوم الحقة.
هكذا نجد، مع مرور الوقت، أنه لم يسْلم مبحث من جرعات اللمسة العِلمية. ويكفي الانتباه إلى الهوامش، وكيف أنها خضعت بدورها للدراسة والتكميم (الجنون، والجنس، والبكاء، والضحك، والتعب، وغيرها)، إذ لا تخلو المكتبات من مؤلفات تعالجها بمنطق التكوين لا الخلق، ولينتبه المرء إلى لغة الأرقام المطلوبة في كل شيء، بما فيها الجانب الرقمي حيث السعي نحو نسب المشاهدة، وعدد المتابعين… هو المبتغى، وليركز أيضا على فكرة الاستراتيجيات والخطط، التي لا يمكن للأفراد والدول السير دونها، فهي أفق العصر، الذي يُنحي العشوائي، ويصبو نحو المزيد من الترشيد والعقلنة حدود المغالاة.
الحداثة إذن هي: العِلم حينما اكتسح واجتاح مشهد حياتنا. إنها ذيوع الأسلوب العِلمي وانتشاره في الجوانب كلها، إلى الحد الذي نعلن فيه – بجلاء- أن الحداثي النموذجي في أقصى تجلياته هو العالِم في مختبره، إذ لم يعد أسلوبه (شكه الدائم، وصناعته للحقيقة، وسعيه للوضوح، وفصله ذاته عن الموضوع للسيطرة، وعزله تكوين الشيء عن خلق الشيء…) حكرا عليه.
2- الحداثة تكرس المحايث وتهمش المفارق.
نبدأ بالسؤال الإشكالي: هل كانت الحداثة ما قبل القرن 17 م؟ نجيب مباشرة بنعم. ولكنها حداثة في الهامش لم تحتل المركز، ونعني بذلك أنها لم تسْر في عروق رؤية العالِم آنذاك، ولم تصل نواة بنية تفكير الجميع، لأن الأفق الفكري كان يغلب عليه الطابع الغائي والمفارق، إذ يتم استدعاء تفسيرات من خارج العالَم للفهم، أما مصير الأفكار العلمية الدقيقة، ذات المنحى الآلي والمحايث (وهي أساس الحداثة) التي راجت قديما، فكانت محصورة ولا تصيب بنية التفكير الجمعي في الصميم. أكيد، قام الفَلك القديم على التكميم والترييض، وأكيد نحا علم البصريات نحو المنهج العلمي بالمعنى الحديث، فتكفي الإشارة أن ابن الهيثم، وهو ابن القرون الوسطى، كان يجري تجاربه “الاعتبار” بشكل صناعي كأنه ابن زماننا، فنجد في كتبه تفسير الطبيعة بالطبيعة، وهذا هو لب الحداثة. لكن هذه الطريقة لم تتعمم لتكون رؤية شاملة للعالَم، بل كانت هامشية تقاوم من أجل البقاء، الشيء الذي تغير في القرن السابع عشر للميلاد جذريا، حيث أصبح المفارق والغائي يتوارى ويعود القهقرى، ليحل محله المحايث والنظرة العلمية ذات النزوع الدنيوي في قلب التصورات.
بهذا نقول: إن الحداثة كانت متوارية، لتنطلق -في لحظة واحدة-كاسحة بعد نجاح الأسلوب العلمي في الاستحواذ على رؤية الناس للعالَم، وتجعل الأساليب الأخرى التي كانت سابقا لها السطوة، تتراجع للخلف تصارع البقاء؛ ونقصد مثلا الرؤية السحرية الإحيائية والرؤية الدينية… وغيرهما.
3- الحداثة كرست التكشف وهمشت التحجب
انطلق مسار التكشف المنهجي، وهو مسار الحداثة، مباشرة بعد انهيار النسق الفلكي (الأرسطي/البطلمي) القديم، حيث تفجرت قبة السماء وأصبحنا دون غطاء و في عراء تام، فحينما رفع جاليليو منظاره أزال حجاب القمر الساحر والجميل ليصبح سافرا كله تراب ونتوءات… وازداد الأمر توغلا بعد أن أخذ العلم الحديث دربه الآمن نحو هتك أسرار الطبيعة، لينتشر المفعول في كل قطاعات الحياةـ إذ لم ينجُ أي مجال من تقشير حجبه وإماطة ألبسته، فالطبيعة أزيل رداؤها الاحيائي السحري لصالح الشفافية الرياضية الصارمة، وعلم النفس فصل اللاوعي عن الوعي، وعلم الاجتماع رفع الاكراه الاجتماعي عن الفرد، والثورة الجينية بشراكة مع الثورة الرقمية هي بصدد تمزيق الحجاب الفاصل ما بين العضوي واللاعضوي وتشكيل السايبورغ (الحيوالة)… وهكذا من الأمثلة التي لا حصر لها والتي تبرز أن الحداثة، باعتبارها الأسلوب العلمي، تتحرك ضد منطق التحجب، وإن كان التحجب براقا وساحرا ويخلق المعنى لربما، إلا أنها تراه وهميا ومضللا، فهي لم تعد تقبل سوى منطق التكشف الذي تراه واضحا ويحقق المردودية والنجاعة.
4- في كونية الحداثة
ندافع بوضوح عن كونية الحداثة، فهي واحدة لا متعددة، وليست منتجا غربيا قط، كما يزعم العديد من الباحثين، بل هي منتج عالمي ساهمت فيه كل البشرية، فكوبيرنيكوس الذي دشن نسف ذهنية التراتب كان تلميذ الفلك الإسلامي بامتياز، فهو مجرد ولادة لمخاض مدرسة الأندلس بزعامة البتروجي وابن رشد ومدرسة مراغة الفارسية بزعامة نصير الدين الطوسي وآخرين كمؤيد الدين العرضي وقطب الدين الشيرازي وابن الشاطر. والمخاض، كما نعلم، أصعب من الولادة. لذلك، لا يمكن القول بأن الرؤية اللاتراتبية غربية، بل هي عالمية، فالفكرة مقبولة كونيا، بإيعاز علمي صلب و صعب رده، مع فرق واحد وهو أن هذه الفكرة فعلت فعلها بقوة في أوروبا واشتغلت على نار هادئة محرجة الناس هناك احراجا نظريا أولا ومن بعدها عمليا، أما نحن فجاءتنا هذه الرؤية وافدة عمليا وليس نظريا ، عن طريق لقاء استعماري قاهر وجارح سمي بصدمة الحداثة، وهو ما جعلنا نتعثر في استيعاب هذه الرؤية إلى حد الساعة، واعتبرناها غربية، يريد الآخر فرضها علينا، بينما هي منظومة عالمية أحرجت الغرب نفسه وهو بالمناسبة لازال يقاومها، وإن بشكل أخف منا. لذلك، لا يمكن التملص تاريخيًّا من شيء وضعنا أساساته، فالحداثة منا وإلينا.
5- الحداثة ليست اختيارا
يتعامل العديد من الباحثين مع الغرب كأنه اختار الحداثة، وهذا مجانب للصواب من جهتنا، لأن الغرب نفسه اكتوى بنار الحداثة، فهذه الأخيرة باعتبارها منظومة فكرية شاملة، ورؤية للعالَم ذات نَفَس محايث (دنيوي)، محايثة منهجية صارمة، بعثرت حسابات الإنسان الأوروبي أولا قبل بقية العالَم؛ ومؤشرات ذلك عديدة، منها أن رواد وبناة النسق الحداثي، لم يُستقبلوا في البداية بأيادٍ مفتوحة، بل تم الحذر منهم والنظر إليهم باعتبارهم مهددو الأمن العام، فكوبيرنيكوس لم يخرج كتابه إلا على فراش الموت، لأنه الراهب الذي كان يدرك تبعات منجزه، ويتودد للبابا على أن لا يقرأ مؤلفه إلا المتخصصين، وغاليليو تم سجنه في إقامة جبرية مُهينة لدفاعه عن النسق الفلكي الجديد بحجج فيزيائية ملموسة، وديكارت كتب بأسماء مستعارة، وكاد أن يحرق أحد كتبه خوفا، لأنه تجند ليضع ميتافيزيقا ملائمة للعلم الحديث. أما داروين، فقد أغلق عليه الأبواب بعد صدور كتابه “أصل الأنواع”، وهو العارف باللاهوت المسيحي وكيف أنه لن يقبل فكرة التحول وفكرة الانقراض المرعبة والأمثلة كثيرة؛ فالأفكار الحداثية نظرا لطابعها العِلمي المحايث الدنيوي، شكلت تهديدا وجرحا شاملا ليس للغرب وحده بل للإنسانية جمعاء، لأنها جاءت ضدا على ما ألِفَه البشر لقرون عديدة.
6- المجابهة الأخلاقية لمآزق الحداثة لا تكفي
إن الحداثة، باعتبارها رؤية للعالم قوامها المحايثة المستأسدة بالأسلوب العلمي، لا ينبغي التعامل معها سوى وفق القاعدة السبينوزية الشهيرة: “لا تضحك، لا تبك، ولكن افهم”. أي علينا أن نقارب الحداثة كما هي، ليس كما نتمنى، فهي أُفق العصر الذي لا يمكن تجاوزه بالتمني أو بالهجوم الأخلاقي، فالحداثة لا يمكن الاستفادة من مكاسبها والظفر بمزاياها، والمتمثلة في المردودية والنجاعة… ولا يمكن أيضا التعامل مع أسقامها وأوجاعها والمتمثلة في هتك الحدود وهدر المعنى. وبشكل نقدي، إلا بالعودة إلى جذورها المتمثلة في العِلم. فهي بمثابة نظرية كبرى لا يمكن مجابهتها إلا بنظرية كبرى أخرى لم يحن وقتها بعد، ولسبب وجيه يتمثل في نجاعة العِلم لحد الساعة. فكل النقد المقدم للحداثة، في عالمنا الناطق بالعربية خاصة، مازال يضرب الأحزمة الواقية ولم يبلغ بعد النواة.