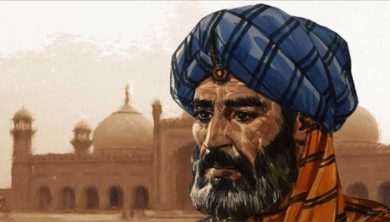هشام روزاق يكتب: في المال والسياسة… لا تضارب في المصلحة الواحدة
صفقات رئيس الحكومة التي عقدها مع الحكومة التي يرأسها، هي في النهاية، ليست خللا في المنطق، وليست فضيحة كما يمكن أن تعيشها تجارب سياسية أخرى، وليست حتى عنوانا لقضية تضارب مصالح… إذ لا تضارب في المصلحة الواحدة.
هي أسوأ من ذلك بكثير…هي ببساطة، عنوان استمرار شكل وجوهر دولة معين، يعتبر المال العام والشأن العام، مجالا محرزا ومغلقا، تمنح فيه ثروات المغاربة المشتركة، لجزء من المغاربة، وتفوت فيه خيرات البلد، لجزء من محظوظي البلد، ويتحول الريع فيه إلى دولة موازية تضبط إيقاعات البلد وتحدد إقامة الحالمين بتغييره نحو مكان أجمل وأكثر عدلا.
… على امتداد تاريخها، وفي حالات كثيرة، ظلت السياسة في المغرب، قرينةَ المال ومرادفه. ظلت حاميته، وظل خادمها.
السياسة، في محطات وحالات كثيرة، لم تكن فقط حامية للثروة، بل صانعة لها. صارت السياسة بالتالي، معبرا آمنا للكثيرين، نحو “تملك” الثروة، وضمان استمراريتها، ضمن شروط الطاعة والاستعداد الدائم لـ “تقديم الخدمة” للأنساق السياسية السائدة، ولنموذج الدولة والحكم المرغوب فيه.
علاقة المال بالسياسة، على امتداد تاريخ المغرب، لم تكن، في أغلب لحظاتها، علاقة ندية بين شريكين في مصلحة، ولا حتى علاقة خادم بمخدوم. ظلت في الغالب، علاقة الصانع… بالمصنوع.
في خطوط التماس مع المجال السياسي، ظل “ممتلك الثروة” يشعر على الدوام، أن أقرب توصيف لحالته، هو أنه “يتصرف في ما لا يملك”، أو لنقل، أنه “مجرد مسير Gérant” لأموال الغير، بمقابل.
… كانت السياسة على الدوام، صاحبة الكلمة العليا، وصاحبة القرار، وكانت الثروة و”مسيروها”، يدركون جيدا، أن مجرد الحديث عن هامش محتمل للفعل بدل التنفيذ، أو هامش للاستقلال بدل التبعية المطلقة وطلب الإذن بالمبادرة، هو ببساطة، إعلان عن نهاية الخدمة، وأن الانفصال الوحيد الممكن في هذه الحالة، ليس هو جرد الممتلكات وتدقيق الحسابات وتصفية الشركة، بل… “التتريك”.
والتتريك في حكاية المخزن والمغرب، “تاريخ” قائم الذات لوحده، يتيح من خلال قراءة صفحاته، فهم تشكل النخب عبر الزمن، واقتفاء أثر تدبير ثروات المغاربة المشتركة، ومنحها للمحظوظين والنافذين، وتحويلها في النهاية، إلى مجرد “زواج متعة”، يمنح الكثير من اللذة وتحقيق الرغبات، لكنه لا يُرتب حقوقا ولا واجبات نظير ذلك.
لأجل ذلك ربما، عشنا في بلدي مع “محدثي النعمة”، ولم نعش تشكل نخبة “رأسمال حقيقية” كي لا نتحدث عن نخبة بورجوازية. عشنا مع “الأغنياء الطارئين”، ولم نعرف بعد بروفيلات الأغنياء القادمين من خارج النسق السياسي القائم والمهيمن.
طبيعة تشكل الثروة في المغرب، وتبعيتها المطلقة للنسق السياسي، وبغض النظر عن موقفنا منها، أو تقييمنا لحجم الضرر الذي، قد تكون، سببته، أو حجم الإفادة التي قد تكون حققتها للبلد يجب، في البداية، أن يُصالحنا مع لغاتنا، ومع حقيقتنا…
ولعل الكلمة المفتاح في هكذا مصالحة، هي الإقرار أولا، بأننا لا نمتلك امتياز الحديث عن “تضارب المصالح”، في حكايات تماس السلطة والمال، خصوصا اليوم مع حكومة أخنوش.
على امتداد تاريخ طويل من علاقة السلطة بالمال، وفي استحضار إيماني لقاعدة التتريك المخزني، ظلت المصلحة الوحيدة في الحكاية هي السياسة، وظلت الثروة و”مسيروها”، مجرد متصرفين وقائمين بالأعمال. بالتالي، ليست هناك مصالح أصلا لتتضارب، ولكن… هناك فقط مصلحة وحيدة، هي مصلحة الحفاظ على القائم، وكبح وفرملة أي طارئ غير محسوب، قد يدخل على معادلة… لم تسمح قط بوجود أكثر من نتيجة واحدة، رغم تغير أطرافها بين الفينة والأخرى.
الذي يحدث اليوم في النهاية، هو ببساطة، استمرار تغيير أطراف المعادلة، في أفق الوصول، دائما، إلى نفس النتيجة. والنتيجة، هي مركزة الثروة، في يد نخبة متحكم فيها، كي لا نقول موثوق فيها. نخبة، تعرف جيدا أن استمرار الثروة، هو في النهاية، استمرار لعملية “تسيير” هذه الثروة، وفق شروط أداء الخدمة.
لأجل ذلك، وكثير غير ذلك… لست أتفاجا اليوم، بحكاية حصول إحدى شركات رئيس الحكومة على صفقة لإنجاز محطة تحلية مياه الدار البيضاء بمبلغ 6.5 مليارات درهم، ولا حتى على صفقة بقيمة 2.44 مليار درهم لتزويد المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب بالفيول، وقبلها صفقة ضخمة للمكتب الوطني للمطارات، من أجل توريد وقود الطائرات…
الأمر في النهاية بالنسبة لي، ليس حكاية تضارب مصالح، فالمال العام، كما الشأن العام في بلدي، ظلا على الدوام حكرا على مصلحة واحدة، تدافع عن نفسها بنجاح، وترسم حدود المسموح به والممنوع منه، بالنسبة لباقي الحاضرين في اللعبة، دون أن يعني ذلك أنهم شركاء فيها.
في المحصلة… حصول شركة أخنوش على صفقات خيالية، وحصول زعيم حزبي “يساري” على أراض في مناطق راقية بمبالغ بخسة، وحصول رئيس حكومة سابق على تقاعد مليوني مريح، وجعل المال العام نهبا لأحزاب تبذره في دراسات “غوغلية” ومنح امتيازات وحصانات ومعابر مالية آمنة لنوع معين من الأعيان والنافذين…… هو في النهاية، استمرار لذات المنطق العتيق في البلد، والذي جعل العلاقة بين المال والسياسة، علاقة المصلحة الواحدة والوحيدة، وجعل التضارب بينهما، إشكالا محسوما، لا يحتاج لأكثر من قرار يصدره الطرف الأقوى في المعادلة، وينفذ على الطرف الضعيف… “التتريك”.
حكايات التتريك في تاريخ المغرب، جديرة فعلا بالاهتمام وإعادة القراءة، إذ أنها تنمحنا كثيرا من تفاصيل ظروف وطبيعة تشكل النخب، ومعها خلق الثروة ومنحها و… استعادتها، كي لا نقول سلبها.
في بعض من حكايات الصحفي الإنجليزي (يعتبر البعض أنه كان أيضا جاسوسا للاستخبارات الفرنسية والإنجليزية) “والتر هاريس Walter HARRIS”، تستوقفنا حكاية واحد من أهم وأقوى الشخصيات في تاريخ المغرب.
يتعلق الأمر بـ “أحمد بن موسى البخاري”، المشهور عند المغاربة بـ “اباحماد”.
والتر هاريس ينقل إلينا تفاصيل ومآلات أسرة وثروة “أبا حماد” بعد وفاته، فيقول:
“طرد المخزن أسر ة ابا أحماد وصارت إلى الفقر والجوع، وأخذ منها عبيدها ليضموا لخدمة السلطان وليباعوا، وضمت أملاكها لأملاك المخزن. إن هذا داخل في العرف المعمول به، فكانت أملاك كبار خدام المخزن تصير إليه إذا هلكوا”.
نعم… في النهاية، هي مجرد ثروات تتم استعادتها، تماما كما يتم منحها، أو منح الحماية اللازمة لتنميتها. ثروات، تمت استعادتها، عبر التاريخ، من قياد ووزراء وفقهاء وعلماء… ومن مختلف تلوينات النخب الممكن تخيلها.
صفقات رئيس الحكومة التي عقدها مع الحكومة التي يرأسها، هي في النهاية، ليست خللا في المنطق، وليست فضيحة كما يمكن أن تعيشها تجارب سياسية أخرى، وليست حتى عنوانا لقضية تضارب مصالح…
هي أسوأ من ذلك بكثير…
هي ببساطة، عنوان استمرار شكل وجوهر دولة معين، يعتبر المال العام والشأن العام، مجالا محرزا ومغلقا، تمنح فيه ثروات المغاربة المشتركة، لجزء من المغاربة، وتفوت فيه خيرات البلد، لجزء من محظوظي البلد، ويتحول الريع فيه إلى دولة موازية تضبط إيقاعات البلد وتحدد إقامة الحالمين بتغييره نحو مكان أجمل وأكثر عدلا.
لسبب ما، تحضرني هنا مقولة جميلة للسياسي الأمريكي “Dick Armey”:
“ثلاث مجموعات تنفق أموال الآخرين: الأطفال، واللصوص، والسياسيون.
الثلاثة يحتاجون دائما لمن يضبطهم، ويراقبهم”.
وهذا… بعض من كلام.