مصطفى مفتاح يكتب: الغرب شريك في الإبادة. لماذا؟
قد نفسر الأمر بإحساس الغرب بمسؤولية على ما تعرض له اليهود من اضطهاد وتقتيل واعتقالات في معسكرات الموت.
قد يكون الأمر مفهوما بالنسبة لألمانيا إلى حد ما، لكن عمليات التصفية les pogroms المتواترة، عرفتها روسيا والدول التي تنتمي إلى مجالها السلافي slave. لهذا، لا يمكن أن يكون لهذا العنصر ثقل كبير. رغم أن كراهية اليهود كانت منتشرة في الغرب و لاتزال، لكن العواطف بما فيها الكراهية، لا تصمد كثيرا أمام منافسة المصالح.
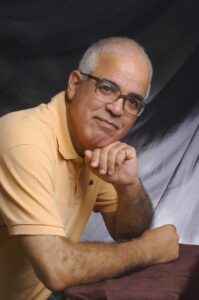
يقول طيب القلب الغربي: “من المؤسف أن جثث الأطفال وأشلاء الحوامل وبقايا الصحفيين والمسعفين والمستشفيات هناك في غزة التي تحتلها حماس لا تتكلم لغة نفهمها!”. يجيبه صاحبه: “والفظيع أن الأخبار لا تأتي إلا من القناة الإخبارية التي لا تحبنا وتضطهد النساء، الجزيرة”؛ فتطبق على تلابيب روحي الضغينة، أقاومها وأحاول أن أفهم.
يؤلف متأنق متعود كتابا كاملا من البكاء بالألوان وبلاطوهات التلفزة في فرنسا عن وحدة “إسرائيل” القاسية وعزلتها مقارنة مع الأطفال والحوامل والأطقم الطبية والمسعفين والصحافيين والمساجد والكنائس والمستشفيات والجامعات التي تحصدهم الغارات والقنابل الأمريكية بالعشرات.
يعبر الرئيس الأمريكي عن غضبه الشديد من استهداف مسعفين من إنكلترا وبولندا وأستراليا، فيقرر إرسال قنابل من الوزن الأعلى إبادة لصالح إسرائيل. لعله يفتتح بورصة أخرى لنزن كم يساوي ألف طفل فلسطيني أو صحافي أو جامعة من الضحايا المنتمين إلى الغرب، حتى تذرف التماسيح بعضا من دموعها الإعلامية.
لا تبهجني اليقينيات الحادة القاطعة حول الغرب و”طبيعته وجوهره” الاستعماري والعنصري و”استكباره”، ولكن الواقع أفظع.
الإجماع لدى الأغلبية الساحقة من النخب الغربية مع إسرائيل وتواطؤها بشكل أو بآخر مع عملية الإبادة الجارية جهارا، ليلا ونهارا في غزة، بشكل همجي غير مسبوق، وكذلك في باقي فلسطين، هو إجماع مثير للتساؤل ومحاولة الفهم.
عنف القمع والانتقام الذي يطال كل من لا يندمج مع الرواية الغربية للقضية، بل ويدافع فقط على وقف إطلاق النار ضد التجويع والإبادة.
سأكتفي بجرد بعض العناصر ذات الدلالة:
فرنسا: منذ 7 أكتوبر 2023 حتى 30 يناير 2024، تم فتح 626 ملفا قضائيا بتهمة “الإشادة بالإرهاب”. من ضمن المتهمين، تلميذة في سن الرابعة عشر عاما، وأكبرهم يبلغ سن الرابعة والسبعين. أما الأفعال، فتتراوح بين اعتبار ما فعلته “حماس” مقاومة وعدم استعمال نعت “إرهابية”.
لن أتحدث عن السياسيين في الغرب. لن أتحدث عن الإعلام، ولو أن ما يقبله نساء ورجال الاعلام في الغرب مريع: منع الصحافة إلا مع دبابات وجنود، وتأطير من الجيش، مع فرض التأشير المسبق قبل البث والنشر.
طبعا، يمكن أن نشير إلى سيف الطرد والتهميش من طرف أرباب الشركات الإعلامية وأصحاب التأثير عليهم…
يمكن أيضا الحديث عن الحافلات التي تذرع جامعة “هارفرد”، للتشهير بكل من سولت له نفسه الحديث عن و”قف إطلاق النار” أو “الإبادة” أو “من البحر إلى النهر”. حافلات تنشر الصور والأسماء والعناوين، مطالبة بدك الأنفاق التي حفرتها “حماس” في نفوس وعقول الطلبة والأساتذة اليهود وغير اليهود، الذين يدرسون أو يعملون في تلك الجامعة العظيمة.
لعل بعض التفسير نجده في الصعود العارم ليمين لا يخجل من العنصرية والاستعمار والشوفينية والعرقية، ويحارب الأمم المتحدة ومنظمة اليونسكو والمحكمة الأوروبية لحقوق الانسان، وتعاطف البابا مع ضحايا قوارب الموت.
يمكن أيضا أن نضيف عنصرا آخر، يتمثل في التحرر الكامل من أي وازع أخلاقي، حيث أصبح الكذب ممارسة عادية في كبريات وسائل الإعلام الأمريكية، بل وظهور منظرين مثل ستيف بانون Steve BANNON ومجموعة QNon، واستخدام هذا السلاح بشكل منهجي من طرف دونالد ترامب وبولسونارو والإمبراطورية الإعلامية لفانسان بولوري Vincent BOLLORE في فرنسا. تعميم الكذب دون عقاب، حتى على الأمم المتحدة.
قد نفسر الأمر أيضا بإحساس الغرب بمسؤولية على ما تعرض له اليهود من اضطهاد وتقتيل واعتقالات في معسكرات الموت. لكن، قد يكون الأمر مفهوما بالنسبة لألمانيا إلى حد ما، لكن عمليات التصفية les pogroms المتواترة، عرفتها روسيا والدول التي تنتمي إلى مجالها السلافي slave. لهذا، لا يمكن أن يكون لهذا العنصر ثقل كبير. رغم أن كراهية اليهود كانت منتشرة في الغرب و لاتزال، لكن العواطف بما فيها الكراهية، لا تصمد كثيرا أمام منافسة المصالح.
يبقى التفسير “الاستشراقي”، خصوصا أن المسألة الفلسطينية برزت بحدة بعد انتهاء الحروب بين الأمم الغربية الرأسمالية مع انتهاء الحرب العالمية الثانية، حيث بقي هناك عَدُوّان للغرب، الأول سياسي-أيديولوجي هو الاشتراكية، ممثلة أساسا في الاتحاد السوفياتي وما اعتبر امتدادات له في الصين، والثاني “إثني” “عنصري”، هو الشرق والجنوب.
مع تمازجه مع بعض التقارب في الانتماء للغرب، بالنسبة لحملة المشروع الصهيوني-الاستيطاني.
هناك أيضا اعتماد النظام الغربي على استمرار التحكم في الموارد الطبيعية وطرق الملاحة والتبادل التجاري الرأسمالي الدولي، وتلعب إسرائيل هنا دور دركي وفزاعة لأنظمة المنطقة وشعوبها، وربما يكون شن حرب الأفيون[1] وتقليد ليوبولد[2] ملك بلجيكا، الذي تكفل بإبادة بضع ملايين من الكونغو، تدربا على الحرب العالمية الأولى.
تفسير آخر أكثر قبحا ولؤما، هو أن ما يجري في فلسطين، خصوصا مع العدد الكبير من مزدوجي الجنسية، يشكل حلما صعب التحقيق في مناطق أخرى، بتمكن بشر من أن يتمتع بحصانة شبه مطلقة لا تنتهي في اضطهاد بشر آخرين، عبر طردهم من أراضيهم وتسييجهم بالجدران وتعريضهم اليومي لممارسات تحط من الكرامة، كالمنع من الذهاب للمستشفى بالنسبة للمرضى أو النساء الحوامل عند بداية أعراض الوضع، أو المرور لحقل تقطعه عليهم الطريق المخصصة للمستوطنين.
بالنسبة للبعض، قد يكون حلما رائعا ومثيرا أن تتمكن دولة من احتجاز البشر دون محاكمة ولا هم يحزنون، أو قنصهم وهم يتظاهرون سلميا أو يتسابقون للظفر بالمساعدات الغدائية، أو أن يسبوا المنظمات الدولية والأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة نفسه، أو يهزؤوا من المحاكم والقوانين الدولية.
ولعلنا نذكر أنه، حتى أمد قريب، كانت الإعلانات للسياحة في بلدان يمكن فيها اغتصاب الأطفال واستعبادهم جنسيا عبر وصلات إشهارية مألوفة، تكاد لا تتستر.
ولعلهم ينتشون أيما انتشاء مسبق بالتمتع بكل ما يعتبرون أن آباءهم وأجدادهم فازوا به ضد السكان الأصليين في كل قارات العالم.
ومن الفظاعات التي نستفيق عليها كل يوم الآن، هي حين نشاهد رئيس أقوى دولة سلاحا ومالا وصناعة، يتلذذ بحلواه المثلجة وشاشات التلفزة تفتح له الشهية بمشاهد إبادة “الحيوانات البشرية” المتواصلة على شبكات التواصل.
بالمقابل، أجد نفسي ملزما بتسليط الضوء اللازم على الانسجام الأخلاقي والصمود الذي عبر عنه العديد من المثقفين والشباب في العديد من عواصم الغرب، بل وحتى من مواطنين إسرائيليين. أذكر بعجالة الآن: “جوديث بتلر” و”ادغار موران” و”ايلان بابي” وآرون بوشنل، الجندي الأمريكي اليهودي الشهيد الذي أحرق نفسه أمام مبنى سفارة إسرائيل في العاصمة الأمريكية، احتجاجا على حرب الإبادة في غزة.
أما العرب الرسميون، فقد أحرقوا وجبة العشاء.
[1] La Guerre de l’Opium de la Grande Bretagne contre la Chine
[2] Léopold Roi des Belges








