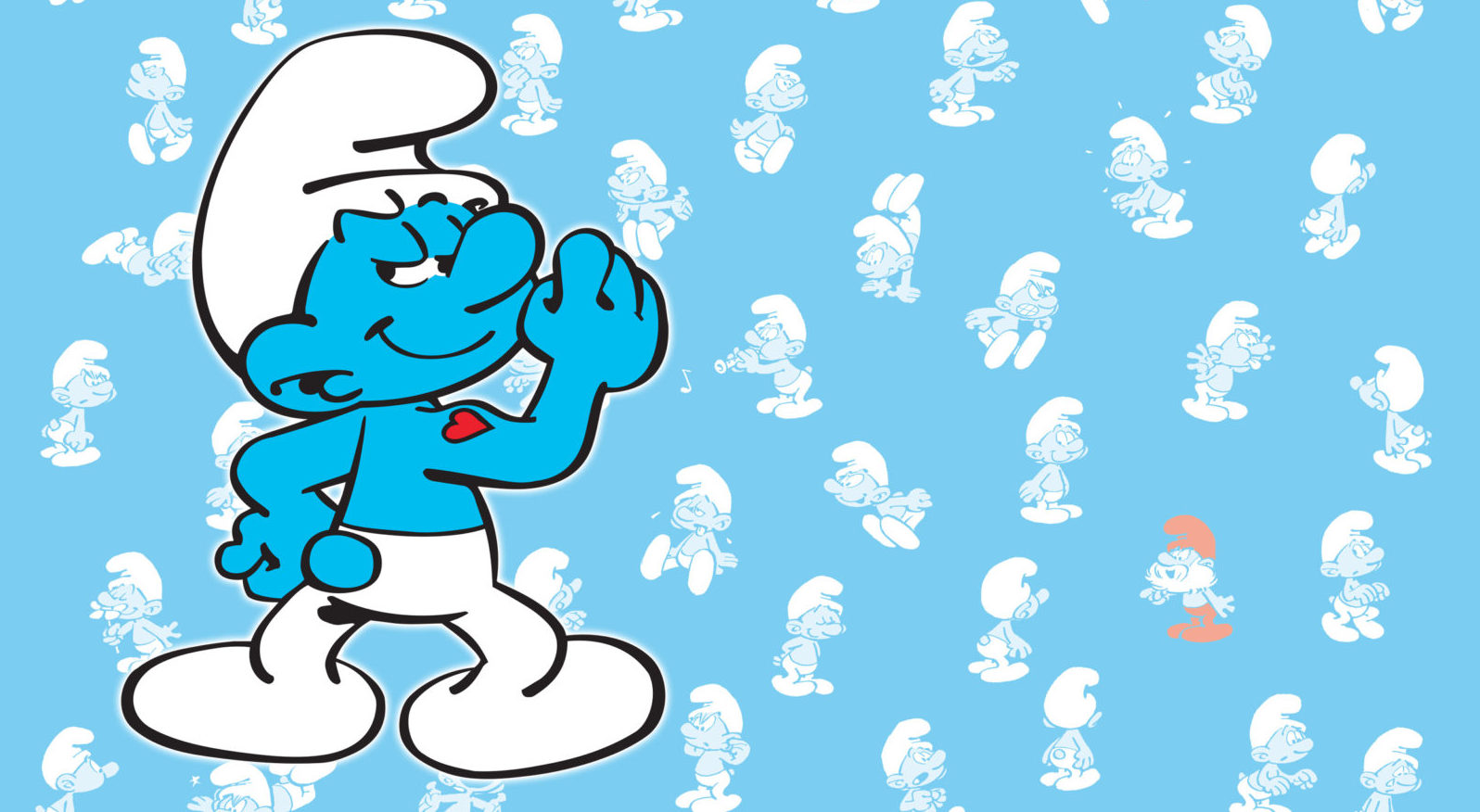من كندا، عبد الرحمان السعودي يكتب: عاشت الولايات المتحدة “السَّنفورية”…
لندع الآن، ولو مؤقتا، مهمة شتم أمريكا للأمريكيين…. ولننظر إلى أنفسنا في المرآة ونعترف، بكل صراحة، بأن بيتنا من زجاج، وأن بداخل كل واحد فينا، جنّي عنصري صغير، يتحكم بتصرفاته أحيانا لإرضاء نزوات عنصرية.
قبل أن تتسرع في الإنكار، تذكر آخر مرة قلت فيها: “عزّي”، “عروبي”، “معوّق”، “دبّوز”، “بايرة”، “زبّال”…. واللائحة طويلة.
صدقني… إن أجمل هدية يمكن أن تقدمها لروح “جورج فلويد”، ولكل الضحايا من قبله، هي تصفية تركتك من الألفاظ العنصرية المخجلة.

كثيرون هم الذين كانوا ينادونني في فترة الطفولة باسمي الثاني: “السعودي”.
لم يكن ذلك يزعجني. لكن السؤال الذي كان يحير عقلي الصغير هو: “لماذا هذا الاسم بالذات، علما أنه لا علاقة لي بالسعودية ولا أنتسب إليها؟ وهل من سبيل الى تعويضه بلقب آخر، له علاقة بي ويعبّر عني؟”. سؤال لم أجد له إجابة…
سلمت أمري لله، وتمنيت بشدة لو أنني أعيش في دولة “السنافر”؛ فهي البلد الوحيد الذي كانت له الشجاعة الكافية لتطبيق قانون “الإسم من جنس العمل”. قانون يرتكز أساسا على معايير أخلاقية وسلوكية لتسمية أي سنفور. من منا لا يتذكر سنفور مفكر، سنفور غضبان، سنفور مهذب والآخرين؟ كل سنفور له اسم مستمد من سلوكه، بعيدا عن أي نسب أو تاريخ أو جغرافيا.
انطلاقا من معرفتي بعالم “السنافر”، كنت على يقين أنه، إذا تحقق حلمي، فليس فقط تغيير لقبي الاعتباطي هو الثمرة الوحيدة التي سأجنيها من “جنسيتي السنفورية”، لكنني سأعيش في مجتمع يكن كل الحب والاحترام لـ”سنفورة”. مجتمع لا يرى في اختلاف الآخرين عيبا فيهم. تعايشه سر سعادته. تكامله وتعاونه سر انتصاره الأبدي على المشعوذ “شرشبيل”.
ماذا تنتظر من بلد كان بالأمس القريب، لا يكتفي بفصل الجنود البيض عن السود في الحروب، بل كانت بنوك الدم أيضا مفصولة. وكأن الجنود سود البشرة كانوا يضحون بأنفسهم دفاعا عن كوكب زحل
بسذاجة الصغار، حلمت باليوم الذي سيتبنى فيه العالم هذه الفلسفة “السنفورية” البسيطة في التعايش. فلا أحد يختلف على أنها كفيلة بحل جل مشاكل وعقد هذا الكوكب. لكن، مع كامل الأسف، سرعان ما يتحطم هذا الحلم، فور الاطلاع على تاريخ البشرية، الذي يؤكد لنا في كل مرة أن تفكير البشر أبعد ما يكون عن تفكير “السنافر”.
اقرأ أيضا: من نيويورك. هشام الرميلي يكتب: أمريكا… لا تستطيع أن تتنفس!
معايير التصنيف والتمييز لدى البشر كانت، منذ العصور الغابرة، غالبا ما تقوم على أساس اللون أو الشكل أو الانتماء الجغرافي أو الديني أو العائلي…. أوغيرها من المعايير السطحية التافهة، التي تحكم على الإنسان بناء على أشياء لا يد له فيها.
الأدهى هو أن هذا السلوك الغبي، تم تكريسه عبر الزمن ليفرز لنا مفهوم “العرق”. بدعة مقيتة، استحدثت لإرضاء عقليات متعصبة، كانت محتاجة دوما إلى آخر لتسقط عليه جميع الأمراض والنقائص، لكي تحتفظ لنفسها بكل الأوصاف الإيجابية الراقية. والأهم هو أن تحتفظ لنفسها بالسيطرة وحق البقاء.
بالرجوع إلى التاريخ، نجد أن فكرة “العرق” ارتبطت ارتباطا وثيقا ببداية النزعة التوسعية والاستعمارية، خصوصا عند الدول الغربية. كانت هناك حاجة ملحة لدى هذه القوى لأن تفرض، بشكل أو بآخر، هيمنة أخلاقية على الشعوب التي تستعمرها.
كانت البداية باستحداث ما يسمى بالتمييز الثنائي (Binarism) الذي كان قائما على ثنائية: “الرجل الأبيض متحضر، والآخرون بدائيون”. وبتالي، فمن الواجب على الرجل الأبيض احتلالهم، من أجل تعليمهم وتنويرهم، فيما سمي بعد ذلك بـ : “عبء الرجل الأبيض” (كان الله في عونه).
هناك مفكرون كثيرون يرون أن الإبادة النازية تكاد تكون متسقة تماما مع العنصرية الغربية، وصناعة الآخر البدائي، الهمجي، المتوحش، المنحط جسديا وأخلاقيا وثقافيا. من أول “كريستوف كولومبوس” الذي ابتكر مفهوم “آكلي لحوم البشر”، لكي يبرر قتل الهنود الحمر، إلى غاية التجليات العنصرية في القرن الواحد والعشرين، التي تظهر على شكل صور نمطية متكررة في الكتب والأفلام والإعلانات والملاعب الرياضية
لكن الانحراف الخطير، كان هو استقرار مفهوم العرق في العلوم البيولوجية، حيث تم استحداث هياكل هرمية للأعراق والأجناس البشرية، وعلى رأسها طبعا الرجل الأبيض.
توالت أعمال ونظريات أخرى، بضم الهمزة لا بفتحها، في مجال هذه التقسيمات “العرقسوسية” للبشر. لكن الطريف والمضحك في الأمر، هو أن أصحاب هذه النظريات، كانوا دائما يصنفون أنفسهم مع العرق الأرقى. وكان كل واحد منهم يقدم هيكلا هرميا على مقاسه، ثم يختار لنفسه أفضل مكان على قمته ليتمدد ويدلدل رجليه.
مع الأسف، لم تسلم الفلسفة أيضا من هذه الجائحة، وتواطأ بعض الفلاسفة لترسيخ تفوق الرجل الأبيض وتبرير الاستعمار. نجد مثلا الفيلسوف الأسكتلندي المشهور “ديفيد هيوم”، يقول في كتابه “السمات القومية”: “إنني أميل إلى الاعتقاد بأن الزنوج عموما وأنواع البشر كافة، أدنى طبيعيا من البيض”. الغريب والمريب أن “أبا الهماهيم”، الملقب بأب الفلسفة التشكيكية، نسى أو تناسى أن يشكك في اعتقاده هذا بالمرة.
اقرأ أيضا: سناء تراري تكتب: صفعة تقدمية
لكن التمييز العنصري بلغ مداه ووصل ذروته، في الكتاب الأشهر، والأكثر تأثيرا في مجال التصنيفات العرقية، تحت عنوان: “التفاوت في الأجناس البشرية”. فهو لم يكتف باعتبار الرجل الأبيض أرقى عرق، بل قدم تقسيما فرعيا داخل عرق البيض أنفسهم، ولم يضعهم في سلة واحدة. ولو كان يعرف صاحب الكتاب، الدبلوماسي الفرنسي” آرثر دي جوبينو”، أن أفكاره ستكون مصدر إلهام لـ”هتلر” المشهور بكرهه الشديد للفرنسيين، لما خط فيه حرفا واحدا.
هل الانتقادات الفكرية والعلمية الرصينة، التي كشفت أن فكرة العرق زائفة ولها عواقب بشعة، استطاعت أن توقف المجازر والإبادات؟ الإجابة بكل أسف، وبكل ألم، هي قطعا: “لا”.
لقد تبنى “هتلر” مفهوم “العرق الآري”، الذي جاء في الكتاب، ليعلن عن ميلاد أبشع تحالف في البشرية، بين الثلاثي: العنصرية، الطب الحديث والقومية؛ مما برر للنازيين التعقيم القسري والقتل الرحيم للرضع والبالغين من ذوي الإعاقات، والاستعمار والقتل والحرق بدم بارد، وغيرها من تجليات الأرضية العلمية والأخلاقية والفلسفية العنصرية، التي وفرت راحة الضمير لأصحاب “هتلر”.
هناك مفكرون كثيرون يرون أن الإبادة النازية ليست انحرافا عن مسيرة الفكر الغربي، بل تكاد تكون متسقة تماما مع العنصرية الغربية، وصناعة الآخر البدائي، الهمجي، المتوحش، المنحط جسديا وأخلاقيا وثقافيا. من أول “كريستوف كولومبوس” في القرن الخامس عشر، الذي ابتكر مفهوم “آكلي لحوم البشر”، لكي يبرر قتل الهنود الحمر، إلى غاية التجليات العنصرية في القرن الواحد والعشرين، التي تظهر على شكل صور نمطية متكررة في الكتب والأفلام والإعلانات والملاعب الرياضية.
لكن، وللإنصاف، فهناك مفكرون تصدوا لفكرة العرق، وسخروا من كتاب “التفاوت في الأجناس البشرية”، وكشفوا أن التصنيفات البشرية العرقية كذب وضلالات. لكن السؤال المطروح: هل الانتقادات الفكرية والعلمية الرصينة، التي كشفت أن فكرة العرق زائفة ولها عواقب بشعة، استطاعت أن توقف المجازر والإبادات؟ الإجابة بكل أسف، وبكل ألم، هي قطعا: “لا”.
فكرة “العرق” ارتبطت ارتباطا وثيقا ببداية النزعة التوسعية والاستعمارية، خصوصا عند الدول الغربية. كانت هناك حاجة ملحة لدى هذه القوى لأن تفرض، بشكل أو بآخر، هيمنة أخلاقية على الشعوب التي تستعمرها
لن تجد أفضل من قائدة العالم “أمريكا شيكا بيكا”، لتؤكد لك حتمية وقطعية هذا الجواب. فقد كانت ولاتزال، الابنة البارة لمؤسسة العنصرية. والمشهد المفجع لـ “جورج فلويد”، لم يكن إلا تكرارا روتينيا للممارسات العنصرية الأمريكية منذ مئات السنين. فماذا تنتظر من بلد كان بالأمس القريب، لا يكتفي بفصل الجنود البيض عن السود في الحروب، بل كانت بنوك الدم أيضا مفصولة. وكأن الجنود سود البشرة كانوا يضحون بأنفسهم دفاعا عن كوكب زحل.
إذا كنت تعتقد بأن زمن العبودية في الولايات المتحدة الأمريكية قد ولى، فدعني أخبرك بأن شركات كبرى تجني ثروات طائلة، بفضل العمالة المجانية التي يوفرها السجناء، أغلبهم من الأمريكيين ذوي البشرة السوداء.
وإذا خيل إليك أن الانتخابات ستغير شيئا، كما يأمل ذلك أخو الضحية “فلويد”، فلا تنسَ أن ثماني سنوات من حكم “باراك أوباما” لم تغير شيئا من هذا الواقع البائس. وليكن في علمك أن % 3 فقط هي نسبة الذين ندموا على انتخاب “ترامب”، المشهور بـشطحاته العنصرية.
اقرأ أيضا: من مونتريال ــ كندا. عمرلبشريت يكتب: سكيزوفرينا… “المهاجرون إلى الله”
لندع الآن، ولو مؤقتا، مهمة شتم أمريكا للأمريكيين…. ولننظر إلى أنفسنا في المرآة ونعترف، بكل صراحة، بأن بيتنا من زجاج، وأن بداخل كل واحد فينا، جنّي عنصري صغير، يتحكم بتصرفاته أحيانا لإرضاء نزوات عنصرية. قبل أن تتسرع في الإنكار، تذكر آخر مرة قلت فيها: “عزّي”، “عروبي”، “معوّق”، “دبّوز”، “بايرة”، “زبّال”…. واللائحة طويلة.
صدقني… إن أجمل هدية يمكن أن تقدمها لروح “جورج فلويد”، ولكل الضحايا من قبله، هي تصفية تركتك من الألفاظ العنصرية المخجلة.
أعلم أنك مع حقوق الإنسان، وأعلم أنك ضد العنصرية. لكن أي انسان؟ وأي عنصرية؟
الإنسان الذي في صفك، والعنصرية التي لا تطرق بابك.
أنا لا أنتقدك، ولا أتهمك… أنا مثلك تماما، ولا أترفع عليك بمثالية فارغة. والدليل على حسن نيتي هو الطلب الذي قدمته إلى “بابا سنفور” للالتحاق بدولة “السنافر”؛ فالأكيد أن معاشرتي لهم ستصرف الجنّي العنصري الصغير الذي بداخلي. شرطهم الوحيد لقبول طلبي، هو أن أبرهن لهم بأن اسمي “السعودي” لا علاقة له بثقافة “الكفيل”، فهم يحرمون وينبذون كل أشكال العنصرية والاستعباد.